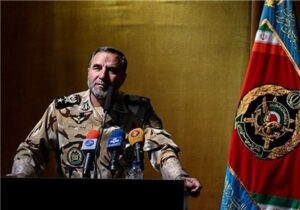ليس من المستغرب أن نقول نحن الفلسطينيين، إن حياتنا بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تغيّرت وغيّرت في الإنسان الفلسطيني، كأنها أعادته إلى اللحظة ذاتها التي عاش فيها التهجير إبان نكبة عام 1948.
الفقد نفسه والمرارة ذاتها، كأنّ 75 عاماً بين النكبة و”الطوفان” ذهبت هباءً، رغم كل ما تختزنه هذه السنون من دماء وتضحيات وأثمان دفعها الفلسطيني إيماناً منه بعدالة قضيته وحتمية انتصارها.
لحظة “طوفان الأقصى” أعادت فلسطين، كل فلسطين التاريخية، القضية الأولى عالمياً، لكنها أيضاً أعادت ترتيب أولويات الفلسطيني نفسه. ذلك أن كل ما أنتجته الأعوام السابقة من محاولات تعايش وتفاوض مع الاحتلال انكشف زيفها وعبثية تحقيقها. هكذا بقيت المقاومة المسلحة الخيار الحتمي والوحيد، الأمر الذي يدفع الاحتلال لإستهداف الوجود الفلسطيني بأشكاله كافة.
إذ يقوم الاحتلال بالتزامن مع تنفيذه إبادة جماعية وتطهيراً عرقياً في قطاع غزة، بافتعال جبهات أخرى مفتوحة في بقية الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل.
حرب على الصوت والصورة واللون والريشة والنص، وهذا يعني أن كل أدوات التعبير التي يمتلكها الفلسطيني خارج القطاع أصبحت في صلب دائرة الاستهداف، لتُشنّ حملة تخريس وتكميم غير مسبوقة للأفواه.
وهذا ربما يعيدنا بالذاكرة إلى عهد الحكم العسكري الذي ساد في فلسطين ما بين أعوام (1948-1967). وعليه فإن كل من يكتب ويرسم من أجل فلسطين مستهدف، وذلك لتحقيق هدف “إسرائيل” في قطع أوصال الشعب الفلسطيني وخلق فجوة بين أبنائه، حتى يشعر الفلسطيني في غزة بأنه وحيد.
تحاول هذه المادة استكشاف آليات تعامل الفلسطينيين، وخاصة الفنانين\ات، مع خصوصية المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية اليوم في القدس والداخل المحتل والضفة الغربية والشتات، حيث تختلف أدوات فرض السيطرة الاستعمارية، وكذلك أشكال التعبير الفلسطيني.
أما لماذا اخترنا الفن والفنانين؟ لأنهم ببساطة الأكثر قدرة على استخدام وسائل تعبير متنوعة لإيصال رسالتهم، وعليه؛ فمن المهم فهم الكيفية التي يقاوم بها الفنانون\ات في فلسطين المحتلة كل أدوات القمع والتحكّم والتخريس التي يتفنن الاحتلال الصهيوني في ابتكارها باستخدام القانون أو حتى بالالتفاف عليه.
فقد اعتمدت المحاكم الصهيونية مؤخراً تهمة “التحريض والتماهي مع التنظيمات الإرهابية”، كوسيلة أساسية لعقاب الفلسطينيين وإدانتهم.
هذا ما حصل قبل مدة مع الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة التي اعتقلتها سلطات الاحتلال بتهمة “التحريض”، لمجرد كتابتها منشوراً على صفحتها على “فيسبوك” قالت فيه إنه: “لا غالب إلا الله”.
اليوم تعتبر حياة هذه الفنانة مهدّدة وسط تعرّضها لحملات تحريض من قبل المستوطنين في الداخل المحتل. وفي السياق ذاته، ألغى مسؤولون في جامعة إنديانا في الولايات المتحدة معرضاً للتشكيلية الفلسطينية سامية حلبي، التي تعد من أهم الفنانات الفلسطينيات المعاصرات، وذلك على خلفية منشوراتها على مواقع التواصل.
يأتي هذا كله في إطار حملات الترهيب والتخويف التي تشنّها الحكومة الصهيونية بشكل ممنهج ضد الفلسطينيين لإخراسهم وتجريدهم من كل أدوات المقاومة، بما فيها المقاومة الإبداعية، وتالياً، خلق حاجز وصراع نفسي بين الفنان\ة وذاته/ا، بحيث يصير الفنان قبل البدء بالتفكير لرسم لوحة جديدة، أو كتابة نص جديد لأغنية أو عرض مسرحي، وكأنه يمارس الرقابة الذاتية على نفسه.
في هذا الإطار، قابلنا الفنانة الفلسطينية ريم تلحمي، وهي مغنية وممثلة من مواليد شفا عمرو شمالي فلسطين المحتلة، سخّرت فنها وصوتها من أجل القضية الفلسطينية، فصدحت حنجرتها عالياً من أجل الوطن.
تعيش تلحمي اليوم في مدينة القدس المحتلة وتعايش همومها وتحدياتها اليومية رفقة عائلتها الصغيرة. طرحنا على تلحمي أسئلة قد تبدو بسيطة، لكن الإجابة عليها ليست كذلك، وهي: كيف تغيّر الفنان الفلسطيني ما بعد 7 أكتوبر، وما هي التحديات الجديدة التي خلقها الواقع الجديد للفنان؟ وما أهمية الفن أصلاً خلال الحرب؟
تقول تلحمي إن: “ما بعد 7 أكتوبر، كأننا فقدنا أدواتنا كفنانين وفنانات فلسطينيات. كأن أدواتنا والفن الخاص بنا سُرق منا. كأنّ هناك استعماراً جديداً بات يوجب عليك التفكير ملياً والحذر قبل القيام بأي خطوة، سواء تأدية أغنية أو كتابة جملة أو تقديم عرض مسرحي. الأمر الذي يجعلك تتوقّف وتتخذ خطوة إلى الخلف”.
وتضيف: “نحن فناني الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، نحمل الجنسية الإسرائيلية، وهنا تكمن المفارقة العجيبة، إذ نعيش ضمن ما يسمى بالكيان الإسرائيلي الذي يتوقّع منا الولاء له، لكن من ناحية أُخرى نقلق من فقدان هذه الجنسية لأنها الوحيدة التي تسمح لنا بالبقاء في بيوتنا وأراضينا وبلدنا فلسطين.
وبالتالي فإن ما يجري اليوم من عمليات تهديد عبر قوانين الطوارئ، تشعر الواحد منا بأنه فاقد للسانه. إنه شعور صعب أن أحس بالعجز والقهر خاصة أنني فنانة ومشروعي الفني والوطني مرتبط تماماً بالقضية الفلسطينية.
هناك عجز عن قول كل ما نفكّر به. لا أحد يأمرني اليوم بعدم الغناء، لكنني لا أعرف إذا غنيت ماذا سيحصل لي، وما هي الأثمان التي سيدفعها أي فنان فلسطيني حقيقي بعد 7 أكتوبر”.
تعتقد ريم تلحمي أن المتغيّر الوحيد الذي حصل بعد “طوفان الأقصى”، يتعلق بشكل مباشر بما حدث ويحدث بالذات الفلسطينية، وبكيفية التعامل مع القلق السائد في داخلها. فالسؤال الذي يدور في رأس أي فنان فلسطيني يحاول العمل اليوم على مشروع فني، يتعلق بالكيفية التي سيُفتتح فيها هذا العمل أمام وجود قوانين الطوارئ.
بمعنى هل يمكن قول النصوص ذاتها التي كان الفنان يقولها قبل 7 أكتوبر؟ الجواب يظل مفتوحاً على سيناريوهات عديدة، فإما أن يتوقّف هذا العمل، وإما أن يعرض بعيداً من كل ما تفرضه قوانين الطوارئ، لكن الثمن سيدفع بطريقة أو بأخرى، والقرار هنا يعود للفنان\ة نفسه\ها.
أمام كل هذه التحديات، تقاوم تلحمي الفنانة كل محاولات الإسكات غير المباشرة التي تتعرض لها، فتسعى للغناء والتلحين، لكنها تجد أن الفن في ظل ما يحصل من إبادة في غزة عدميّ.
وتقول: “كلما رأيت الكوارث الحاصلة في غزة، أفقد صوتي، وأحتاج وقتاً لاستيعاب ما يحدث وترجمته من خلال نص أو لحن. أعتقد أن الصوت مرتبط بالحالة النفسية، وبقدرة الفنان على تجاوز الحدث الكارثي لكي يستطيع متابعة عمله. أحاول دائماً لكنني أفشل”.
تعطي تجربة تلحمي انطباعاً واضحاً عن حال الفنان\ة الفلسطيني/ة في القدس والداخل المحتل اليوم، لكننا لا يمكننا تعميمها. فالمناطق الفلسطينية تختلف من حيث أساليب السيطرة الاستعمارية وطرق فرضها.
إذ بينما يصمت فنانو القدس والداخل المحتل لحساسية وتعقيدات الظروف التي يعايشونها، يستكمل فنانو أراضي الضفة الغربية ممارسة فنهم بأدواتهم الخاصة.
هذا ما يحصل مع التشكيلي والخطاط محمد العزيز عاطف اللاجئ في مخيم العروب شمال مدينة الخليل. إذ يرى هذا الشاب أنّ للفن دوراً تحريضياً وتأريخياً خلال الحروب، يتجاوز الدور الجمالي، وذلك من خلال توظيف الفن لإيصال الصورة والرسالة وتحريض المتلقّين أو التأريخ والتوثيق لمرحلة معينة من الزمن.
ويأتي ذلك انطلاقاً من واجب الفنان الذي يمتلك القدرة على التعبير الدائم والتحدّي في كل ظرف وسياق تتعرّض له القضية الفلسطينية.

يقول العزيز عاطف في لقاء خاص مع “الميادين الثقافية” إن: “التخريس وقطع الألسن وتكميم الأفواه قد ينجح مع الكثير من الأشخاص، لكنه ممنوع أن ينجح مع الفنان لأنه يمتلك القدرة والكيفية التي يعبّر فيها عن ذاته وقضاياه وهموم شعبه.
أعتقد، ويأتي اعتقادي من عقيدة أؤمن بها كفلسطيني، أنّ على كل فنان أن يكون انعكاساً لقضاياه التي يعيشها، وخاصة إذا كانت قضية سامية كالقضية الفلسطينية.
وفي ظل هذا الاستثناء داخلها وهو الحرب الجارية على الفلسطينين في قطاع غزة، يعتبر دور الفن هنا مهماً جداً للتأريخ والتعبئة وللانعكاسات عن الصورة الحقيقة عما يحصل على الأرض”.

يعرّف عاطف الفن في سياق الحروب بأنه “كل أدوات ووسائل التعبيد أمام المقاومة الخشنة والصلبة التي يحتاجها الفلسطيني لعمل تحرّر حقيقي على الأرض”، معتقداً بأن الفن مجتمعاً لا يمكن أن يكون بديلاً عن المقاومة بطرقها الخشنة كما يحصل في غزة وبعض مناطق الضفة وفي شمال فلسطين المحتلة”.
منذ لحظة 7 أكتوبر، لجأ عاطف إلى الفن عبر عمل لوحات عن الإبادة الجماعية في غزة، وعن صورة الانتصار الفلسطيني وكل ما تتعرض له البلاد، مستخدماً مجموعة من التقنيات منها الرسم على الجهاز اللوحي والرسم على الورقة والقلم بالحبر الجاف واللوحات الزيتية.
ويضيف عاطف: “أكثر الأعمال التي لامست قلوب الناس هو عمل المظلة الشراعية التي تحمل علم فلسطين، وهي التي تجسّد صورة المقاوم الفلسطيني الذي هبط بالمظلة صباح 7 أكتوبر 2023 مهاجماً كيان الاحتلال في مستوطنات غلاف غزة، وهناك عمل يجسّد قصة الشهيد الطفل يوسف، وهو الطفل الذي قصفه الاحتلال في غزة وكانت أمه تبحث عنه واصفةً إياه بيوسف الحلو”.

واستوحى التشكيلي الفلسطيني من النجمة السداسية المعروفة بــ “نجمة داوود” أعمالاً فنية عديدة ضمن ما أسماه بــ “الفن المُهاجم”، وذلك انطلاقاً من كون هذه النجمة تمثّل شعار “دولة” الاحتلال التي تهدّد الفلسطينين وتقتلهم، وبالتالي يعتبر عاطف أن من حقه مهاجمة الشعار وتكسيره فنياً وهندسياً.
كما أبدع عاطف في توظيف عنصر “الطوبة”، وهي الحجارة المهدومة التي تغطي أرض غزة بفعل القصف المستمر. ولعل الذي يميّز عاطف كفنان، أنه أبدع دائماً في توظيف فنه بالطريقة التي تتلاءم مع السياق الذي يوجد فيه. فعند اعتقاله داخل سجون الاحتلال، استخدم الفن كأداة في عملية الهروب النفسي والمعنوي من السجن عبر إنجازه لوحات بالخط العربي معتمداً الحبر الجاف وورق القهوة الموجود في السجن. ثم عند خروجه من السجن استطاع تحرير بعضها ونشرها في معرض فني بعنوان “غرفة رقم 14” .

لا حدود جغرافية للمقاومة الإبداعية إذاً. فالفنانون الفلسطينيون لا تنحصر رسائلهم بوجودهم داخل الحيّز الجغرافي المسمّى “فلسطين المحتلة”، بل تمتد لتشمل العالم بأجمعه.
إذ إنّ الفنان الفلسطيني موجود في مناطق مختلفة في الشتات، حاملاً معه صوته وقلمه وأثره. هذا ما أثبتته سهاد الخطيب، الفنانة التشكيلية التي وُلدت عام 1979 في عُمان، ونشأت في الأردن والولايات المتحدة، حاملةً معها قصة لجوء عائلتها من مدينة اللد، ومُعبّرةً عن قضية فلسطين بطرق فنية مختلفة إحداها الرسم.
تقول سهاد الخطيب إن نقل رواية الفنانين الفلسطينيين في الشتات ليس سهلاً، ذلك أن الشتات ليس مكاناً واحداً بل مجموعة من الأشياء التي تعتمد على الجغرافيا والظروف المحيطة والقاعدة المعرفية للفنان، مضيفة أنها لم تعد تعرّف نفسها على أنها فلسطينية من الشتات منذ بداية أحداث 7 أكتوبر، بل فنانة في المنفى، وذلك بسبب شعورها بالحالة المكثّفة من الاغتراب التي فرضتها أحداث “طوفان الأقصى”. هذا الشعور النابع من عدم قدرة الفلسطيني الموجود خارج حدود الأراضي المحتلة من أن يكون موجوداً مع أبناء شعبه ليتشارك المعاناة ويدفع الثمن، إضافة إلى تعرّضه للقمع ومحاولات الإسكات حيث هو موجود.
وعند سؤالها عن آليات ممارستها للفن بعد 7 أكتوبر، قالت الخطيب: “على المستوى الشخصي، أنا كنت أرسم دائماً باستخدام الحبرين الأسود والذهبي، ولكن منذ بداية المجازر في غزة، لم أعد أستطيع إلا رؤية لون الدم. أما في كتاباتي عن غزة فأقول: “فتصبح غزة كل شيء، هي الشيء وعكس الشيء، هي الفخر وهي الحزن”.
وأعتقد أن هذه الحالة التي نعيشها اليوم. أمّا على المستوى الجمعي، فإنني أرى أن هناك حالة من الابتعاد عن المستنقع الفكري الذي تورّط فيه الفنانون الفلسطينيون في الخارج بسبب طبيعة المؤسسات والمنح والمواضيع المقدّمة والمطروحة، وهي البعيدة عن الفكر المقاوم.
اليوم هناك الكثير من الفنانين في الشتات\المنفى يرفضون أن يكونوا موجودين في هذه المساحات المشروطة والمموّلة من الأنظمة المشاركة بشكل مباشر في العدوان على غزة”.

وتُضيف الخطيب: “أعتقد أن ما يحصل ثمنه غالٍ جداً، لكنه على الأقل يدفعنا كفنانين نحو التحرّر بفنّنا والرجوع إلى الفنّ المقاوم في سبيل الحفاظ على استمرارية السردية الأصيلة للقضية الفلسطينية التي تعلّمناها من ناجي العلي وغسان كنفاني، اللذين اخترقا الزمان والمكان في فنّهما وتركا لنا الإجابات عن الكثير من الأسئلة التي نطرحها اليوم على أنفسنا كفنانين، وذلك بهدف الارتقاء بهذه اللحظة العصبية عبر الفنون الفلسطينية المقاومة والبعيدة عن كل المستنقعات الفكرية المشوّهة.
لمى غوشة
أ.ش