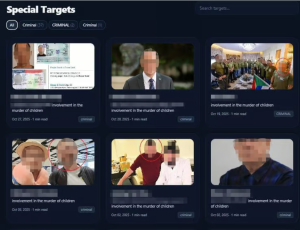“مات أبونا”. كأنّ النبأ شأنه شأن الموت نفسه، إذا وقع بك، فما أهمّية النار التي تستعر من حولك؟ هكذا بدا مشهد الوجوم العام الذي حلّ بوجوه الناس الذين لا يزالون ينتظرون ظهوره “من تحت الأرض” أو أن يعلن نبأ ارتقائه بنفسه!
ليس ضعفاً أن يخلد محبّو السيّد الشهيد حسن نصر الله في حالة إنكار عميقة، إنّما حتى اللحظة هي حالة من حالات الوفاء للمحبّة، للانتماء، وللعزوة. “عزوتنا إنت يا سيّد، فداك المُهج والبيوت، المهم تضل بخير”، أليست هذه شارة كلّ الجنائز؟ ثمّ كيف يترسّب نبأ الموت على من كان الدليل؟ دليل النّاس إلى الطريق، دليل الناس إلى مفاتيح القيود، دليل الناس إلى فقه الفردانيّة، دليل الناس إلى وحيدي الأرض، دليل الناس إلى كلّ أدوات القتال، دليل الناس إلى البأس الأسطوري الذي تَصدُق فيه القصص الخيالية، دليل الناس إلى الله، دليل الناس إلى الحريّة، دليل الناس إلى أنفسهم، ثم يقع الموت، فيصدّقونه؟
أوّل الأشياء التي لا يزال الناس يستهيبون التفكير بها: من سيملأ فراغ المواقيت؟ من سيردّ على القتل والظلم وقلّة الناصر؟ من سيرتّب الكلام المناسب في الوقت المناسب؟ من سيهوّن أعظم المجازر بالطمأنة الإلهية المنبسطة على ملامحه، وبالثأر، من سيرفع من شأن أحزاهم وأوجاعهم مثلما يصنع الآباء؟ نطرح هذه الأسئلة على لسان الناس لغاية التمهيد. الوقت ضيّق للحزن، فالاحتلال يهدّد باجتياح لبنان برّاً، وطائراته لا تزال ترمي بصواريخ وقنابل الموت على المدنيّين، وها هو اليوم يوسّع دائرة النار.
يا أشرف الناس
“أيّها الكرام، يا أشرف الناس، وأطهر الناس، وأكرم الناس (…). أهلاً بكم جميعاً من الجنوب المقاوم المقاتل إلى البقاع الصامد إلى الشمال الوفيّ إلى الجبل الأبيّ إلى بيروت العروبة إلى ضاحية العزّة والكرامة. أنتم اليوم تُدهشون العالم من جديد، وتثبتون بحق أنكم شعب عظيم، وأنكم شعب أبيّ، وأنكم شعب وفيّ، وأنكم شعب شجاع (…) أيها الناس، يا شعب لبنان، يا شعب فلسطين، يا شعوب أمتنا العربية، من 25 أيار/مايو 2000 بدأ زمن الانتصارات وولّى زمن الهزائم، لن تكون هناك هزيمة على الإطلاق” (خطاب النصر، تموز/يوليو 2006).
لم تتبلور العلاقة بين السيد نصر الله وجمهوره في صيغها الرسميّة: قائد وجمهور وبنود عمل وأهداف مشتركة. إنّها قصّة طويلة. خرج “الفتى حسن” مطلع الثمانينيات يحمل مُكبّراً للصوت، مُتوسّطاً النّاس، إما على الأرض وإما مُعتلياً عتبة عالية حتى يكون مرئياً أمام الجميع، يُخاطبهم عن قرب، عقب الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982. عاش مع الناس وحمل في قاموسه اللغوي “عاميّة” المناطق التي عاش فيها بين بيروت والجنوب وبعلبك. ذكيّ في التقاط الفوارق، فينطق كلمة أو جملة بلهجة منطقة ما، فيميل إليه أهلها، حتى بات نسقاً مُحبّباً في خطاباته، حين يقرر التعقيب على أمر، فينتقي أكثر ما يفيه من اللفظ قبل انتقاء الكلمة نفسها.
تدفّق السيّد بين الناس بروحه الثورية ابتداء من الأحياء والمساجد والجامعات والبيوت والجبهات، وصولاً إلى بناء تشابكات فكرية. أراد من الناس أن يُلهموه بفردانيّتهم من أجل تعميق الهدف الذي خرج من أجله: قتال “إسرائيل”، وابتكار وسائل موازية للتطور العسكري والتكنولوجي، من خلال العقل البشري وميّزات الناس ومهاراتهم في مجالاتهم كافّة. وكانت الحروب المتتالية التي عصفت بالبلاد اختبارات بالتجربة، ليس للناس وتصديق وعوده معها فحسب، إنّما للسيّد وثقته وتعويله على الناس أيضاً وأولاً. لهذا، في خطابات كثيرة، خصوصاً في المحطّات التي تطلّبت من الناس تضحيات، رفع السيّد نصر الله من شأن هذا التكافل الاجتماعي البشري المحيط بالمقاومة عاطفياً وعملياً، فهو في النهاية ابن هؤلاء النّاس. وُلد بينهم وعايش مآسيهم، وابتعد عنهم رغماً عنه، وعبّر في كثير من المرّات عن أمنياته في أن يكون بينهم ويزورهم في بيوتهم ويتحدث إليهم مباشرة.
في علاقة السيّد نصر الله مع مناصريه وجمهوره خطّان موازيان: الثقة وتبادل الثقة. تمكّنت تجربة المقاومة من أن تبني مع مناصريها علاقة تبادلية من المنفعة: قتال وانتصار في مقابل احتضان وثبات وصمود. لم يكن السيد نصر الله يوثّق في خطاباته المتتالية لأحداث بعينها، ولا تعقيباً على محطّات ومستجدّات فحسب، إنّما كان يخطّ منهاجاً مفصّلاً وواضحاً يمتدّ على تجربة المقاومة التي قرّر هو ورفاقه منذ وضع الحجر الأساس لها أنّها لن تنتهي إلا بتحرير الأرض وتحقيق الهدف: إزالة “إسرائيل” من الوجود. وفي هذا المنهاج، جنّد الناس وجمهور المقاومة ليكونوا جزءاً من هذا الهدف، وعمّر ثقته بهم تعميراً، فتحدّث عن أشغالهم وعلمهم وإمكانياتهم، ويسّر للمسؤولين داخل مؤسسات حزب الله كل ما يعزز من الإمكانيات الفردية العلمية والاجتماعية والأكاديمية والثقافية لهذا الجمهور.
تخرج هذه العلاقة التبادلية من الثقة بين القائد والناس إلى الواجهة بشكل مغاير اليوم. في لحظة ارتقاء السيّد، شعر محبّوه بالبتر، متيقّنين بأنّ صادق الوعد سيخرج من المصباح، ولن يحلّ عليه الفناء. وقع شرخ عاطفي في هذه العلاقة. كان السيّد يعلم، كما الذين سبقوه ممن ارتقوا في هذه المعركة والحروب السابقة، أن طريق ذات الشوكة ممتلئ بالتضحيات الجسام، فجنّد روحه لتكون جزءاً من القربان الكبير. ما تهيّأ له السيّد لم يفكّر فيه الناس: “ضلالٌ أنا لا يموت أبي، أنا لا يموت أبي”، لكنّ ذلك لا يلغي كل ما عمل السيّد على مراكمته في هؤلاء المحبّين الصابرين الثابتين الشرفاء الكرام، كما وصفهم. وإن كان وقع الاغتيال الغادر قاسياً اليوم، فإنه سيشعل نار الثأر في القلوب، وهذه النار لن تشتعل بغير مكانها. لقد ترك السيد نصر الله في الناس مشروع أمّة، ترك فيهم ثقته. لقد تأخّروا في اغتياله حتى مكّنوه من أن يتجاوز قيادة حزب إلى قيادة مشروع أمّة.
ما هي المسؤولية اليوم؟ السؤال الأبرز والأهم الذي يجب أن يبدأ بالترسّب في الوعي الجمعي. ما الذي تراكم فينا على مدى 32 عاماً من العيش تحت قيادة السيّد؟ ماذا يريد منّا؟ من يستمع فقط إلى خطابات السيد نصر الله في الأشهر الأخيرة سيتنبّه إلى ما أوجزه من قصّة الصراع الأساسيّة، حين تحدث عن التهديد الوجودي لقضية فلسطين، والخطر الذي سيطال الشرق الأوسط كلّه من جراء ذلك. قال إنها معركة للأمة، لا لفلسطين وحدها. فلنؤجل الحزن إذاً. إنه وقت الثأر وتنفيذ الوصايا.
وها هي عينه على البلاد ومُحبّيه من سمائه العالية، يردّد كما كان يردّد دوماً في بداية كلّ خطاب: “ممنون، ممنون”، حتى يهدأ لهيب الناس المشتاقون لطلّته. “لبّيك يا نصر الله”، يُنادون بحناجر تودّ لو تكون مراسيل منفردة ليتعرّف السيّد إليها، ثمّ يختمون التحايا بـ”يا الله يا الله احفظ لنا نصر الله”.
غفران مصطفى