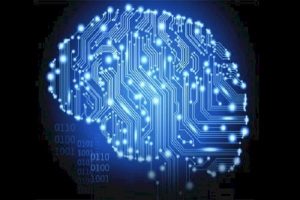يتصور البعض ان درجة إيمانه له دور في نسبة دعمه من الامداد الغيبي، بينما القرآن الكريم وسيرة المعصومين تدعونا الى العمل الجادّ والمثابرة والاجتهاد لتحقيق الاهداف النبيلة في الحياة الدنيا مع الاخذ بنظر الاعتبار النتائج المترتبة للاعمال في الحياة الدنيا على الحياة الآخرة…
{وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} سورة الطلاق، الآية3
قدرتان في طريق الانسان للقيام بأي عمل في حياته؛ القدرة المادية، متمثلة بما يمتلكه من قوة عضلية وذهنية، الى جانب الظروف المحيطة به ذات التأثير في عمله وحياته، والقدرة المعنوية غير المحسوسة المرتبطة بقدرات لا متناهية، وغير محسوبة ايضاً، وهي قدرة الله –تعالى-، وهي القدرة التي مارى فيها الفلاسفة في الازمان الغابرة، ثم توصل اليها علماء العصر الحديث ممن خلال دراستهم لعلوم الطب والحيوان والنبات، وحتى الاحياء المجهرية، والظواهر الطبيعية والكونية، هؤلاء مع التزامهم المنهج التجريبي وابتعادهم عن المنهج الإيماني- التسليمي- إن جاز التعبير، فانهم يقرون بوجود هذه القوة القاهرة والمؤثرة في الوجود، وإن لم يحددوا هوية صاحبها.
وبما أن المنهج الايماني الداعي الى مفاهيم مثل؛ التوكل، والقناعة، والرضى، والقضاء والقدر، وكلّ ما ينبه دائماً الى تفوق القدرة الغيبية على العوامل المادية، فان الفكر الديني يعد القدرة من “الاسباب الواقعية المهيمنة على الاسباب الظاهرية”، (خطوات نحو النجاح- السيد جعفر الشيرازي)، فربما يفعل الانسان كل شيء لتحقيق أمر ما، كأن يكون طبيباً وجراحاً ماهراً في غرفة العمليات، او طياراً مخضرماً ذو خبرة طويلة في مئات الرحلات الناجحة، ولكن خطأ فنياً او ظروف جوية مفاجئة، او شيء خارج إرادة هذا الانسان يقلب الأمور رأساً على عقب بشكل صادم ومريع.
قانون الاسباب وعوامل الإسناد
الى جانب هذه الحقيقة الدينية ثمة تأكيدات وافرة من القرآن الكريم وسيرة المعصومين، عليهم السلام، على ضرورة التقيّد بقانون السبب والمسبب، فلا وجود للمعاجز والخوارق على طول الخط، إنما عمل الانسان نفسه ضمن الانظمة الاجتماعية والاقتصادية الواضحة والمتوافقة مع الفطرة السليمة، فالرجل لن يكون أباً ولا المرأة تكون أمّاً إلا بالتقاء الاثنين وفق شروط وضوابط معينة، وتكون ثمرة الزواج؛ الابناء، وهكذا المال وايضاً العلم وكل ما يبحث عنه الانسان في حياته، {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى}، وهذا النفي يؤكد هذه الحقيقة الوجدانية، فلابد من الحركة، والعمل، والاجتهاد، والتفكير، والتدبّر.
هنا يتوقف البعض هنيئة ليعتريه شعوراً بالتملّك؛ ليس المال والبنون، وإنما القدرة على القيام بما يريد، وأنه ضامنٌ –بالضرورة- لنتائج أعماله، فهو عندما يخوض غمار التجارة –مثلاً- بأمواله وذكائه الاجتماعي، مع مجموعة عوامل يعدها عناصر لضمان النجاح، يغمره شعوراً بحتمية هذه النجاح، فيبني الآمال العريضة ويرسم الأحلام الوردية، بل ويهيئ لتفوقه بوعود من نسج الخيال لمحيطه الاجتماعي بأنه سيصبح ذو شأن، ولكن! حادث عرضي غير متوقع يسبب تبخّر كل تلكم الآمال والأحلام، مع آثار صدمة عنيفة على الصعيد الشخصي والاجتماعي، وهذا نراه ماثلاً للعيان على صعيد التجارة، والسياسة، وحتى التعليم.
توفر عوامل النجاح ليس بالضرورة يقود صاحبه الى ما يريد، انما يحتاج الأمر توازناً دقيقاً بين قدرات الانسان وعوامل الغيب، وما يُسمى احياناً “الامداد الغيبي”، من خلال مراعاة الضوابط الأخلاقية ليكون النجاح حقيقياً له آثاره الايجابية على ارض الواقع، من إفادة الناس في الحاضر، ومن ثمّ الاستمرارية في العطاء على أمد بعيد، والتي تُسمى “الصدقة الجارية”، وإلا فان الزعيم الالماني النازي كان يعد نفسه ناجحاً، بل حتى العالم حينها كان ينظر اليه بانبهار لما توصلت اليه بلاده من تقدم تقني هائل، بيد أن كل جهود الشعب الالماني، رجالاً ونساءً وحتى اطفالاً، وليل نهار، ذهبت مع دخان حرب مدمرة أزهقت أرواح فيها حوالي سبعين مليون انسان.
ولمن يتحدث عن التقدم العلمي والتقني في الغرب عليه الالتفات ايضاً الى حجم المشاكل والازمات التي أنتجتها الانظمة السياسية التي توظف هذه القدرات العلمية لاهداف التوسع والهيمنة في العالم، الى جانب الازمات التي بات يتخبط بها الانسان الغربي، مثل الأزمات النفسية، بسبب ضغوط العمل، وفشل العلاقات الجنسية، وانتشار الأوبئة، الى جانب مشاكل معيشية لا تُعد، علماً أن هذه الظواهر السلبية لم نكن نشهدها في بدايات الثورة الصناعية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، إنما بدأت مع مطلع القرن العشرين، فقد كان الانسان الغربي يفكّر ويبدع وينتج من اجل حياة أفضل، وقد تحقق له ذلك وفق الوعد الإلهي: {كُلاًّ نُمِدُّ هَؤُلاء وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً}.
وعليه؛ فإن المشكلة ليست في وجود القدرة لدى الانسان من عدمها، وإنما في دور الأخلاق في توجيه هذه القدرة، فكلما كان هذا الدور أقوى في الساحة العملية كنّا أقرب الى حظوة الامداد الغيبي والتوفيق الإلهي وفق القاعدة القرآنية: {فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ}، فإذا كان العمل والتحرك في طلب العلم او المال او المنصب بعيداً الأخلاق الاجتماعية فمن المؤكد سيذهب جفاء حاله من حال زبد الماء.
التوازن بين الطموح في الدنيا وفي الآخرة
يتصور البعض ان درجة إيمانه له دور في نسبة دعمه من الامداد الغيبي، بينما القرآن الكريم وسيرة المعصومين تدعونا الى العمل الجادّ والمثابرة والاجتهاد لتحقيق الاهداف النبيلة في الحياة الدنيا مع الاخذ بنظر الاعتبار النتائج المترتبة للاعمال في الحياة الدنيا على الحياة الآخرة.
ولم يجانب الحقيقة؛ عديد المفكرين والمصلحين من علماء الأمة عندما بينوا حجم الخسارة الفادحة التي مني بها المسلمون بتخليهم عن تراثهم الغني بعوامل النجاح والتفوق، يكفينا الإشارة الى وصية أمير المؤمنين في آخر لحظات حياته: “الله الله في القرآن لا يسبقنكم العمل به غيركم”، بمعنى أن المسلمين لديهم القدرة بأن يعيشوا السعادة الحقيقية في الحياة الدنيا وفي الآخرة لو أنهم عرفوا “طريقة الاعتدال في استثمار قدراتهم كما بينها أهل البيت، عليهم السلام، لهم في حياتهم اليومية، بما ينير لهم الدرب في مختلف انحاء الحياة المادية والمعنوية”. (الطموح في حياة الانسان والمجتمع- المرجع الديني الراحل السيد محمد الشيرازي).
فالامداد الغيبي لا يأتينا على طبق من ذهب حسب طلباتنا ورغباتنا، إنما بالعمل الصالح المستمر على طول الخط دون كلل ولا كسل.
محمد علي جواد تقي