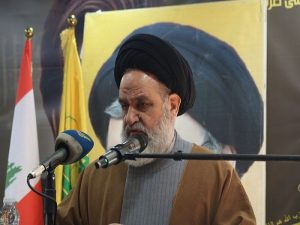انه التوازن الدقيق بين العقل والعاطفة. الشباب يحظون بطاقات بدنية وذهنية هائلة بفضل المرحلة العمرية الطرية، فكل شيء عندهم “درجة أولى” وفي حالة البِكر؛ من القوة العضلية، والمشاعر المرهفة، والذهنية الوقادة، فلا غرو أن نجد معظم التحولات في حياة البشرية كانت قائمة على جهود وتحركات الشباب في الأعمار المتراوحة بين الثامنة عشر الى سن الثلاثين من العمر تقريباً.
وبمقدار ما يتركه الشاب من بصمات تؤثر على واقعه الاجتماعي بفضل ما يمتلكه من طاقات، فان هذه الطاقات نفسها ربما تكون سبباً في أن يكون هدفاً لمؤثرات من جهات أخرى لها أدواتها في التأثير والتعبئة لأهدافها الخاصة.
حتى لا يحصل الخلل في المعادلة
إن مشاريع تغيير كبرى حصلت في العالم، منها؛ الرسالات السماوية وما تركته من آثار عميقة في النفوس نراها جليّة اليوم والى أمد غير معلوم، كانت بفضل تفاعل الشباب واندماجهم مع تلكم المشاريع التغييرية والإصلاحية، ولا أدلّ على ما نقول من أقرب المقربين الى النبي الأكرم، صلى الله عليه وآله، في بداية دعوته الى الإسلام، فقد كان الى جانبه علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وآخرين، الى جانب هذا الأداء الايجابي، فان حروباً طاحنة على مر التاريخ أحرقت الحرث والنسل كان وقودها الشباب على الأغلب، وهذا ما عايشناه حتى السنوات الاخيرة في بلادنا الاسلامية، ومنها العراق.
والسبب في هذا الخلل القاتل فقدان حالة التوازن بين ما يمتلكه الشاب من مشاعر جيّاشة وحماس جامح، وما يمتلكه من عقل وهبه الله –تعالى- له، ولكل انسان منذ لحظة ولادته، فينمو ويتطور ويتبلور مع تقدم عمر هذا الانسان، فالشاب، وهو على مقاعد الدراسة –مثلاً- يرسم في ذهنه خرائط كبيرة لمستقبل مفترض وجميل بعد إكمال دراسته وتخرجه من الجامعة، وايضاً؛ ما يتعلق بحياته الاجتماعية، وتحديداً مسألة الزواج، فهو يندفع بحماسه وبمشاعر حبّ الذات، والثقة العالية بالنفس على أمل تحقيق آماله دون استشارة العقل لديه، والنظر في مدى إمكانية تحقيق هذا العمل أم لا؟ أو صحة هذه الوسيلة لتحقيق الهدف أم لا؟ وكلما حقق الشاب هذا التوازن، بنفس القدر يكون أقرب الى تحقيق آماله بما لا يحلق الضرر بنفسه وبمحيطه الاجتماعي.
وفي القرآن الكريم وأحاديث المعصومين، عليهم السلام، إشارات واضحة الى هذا التوازن، فقد دعا نبي الله نوح، عليه السلام، ابنه لأن يلتحق به ويركب السفينة بعد أن غمرت مياه الامطار وينابيع الأرض كل مكان، أخذ الابن يسبح في ظنه أن في بحر او نهر، ثم قال لأبيه: {قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنْ الْمَاءِ قَالَ لا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ}، إنه فضّل قواه العضلية، واعتداده المفرط بنفسه، على حقيقة البلاء النازلة من السماء بسبب العصيان والتمرد على مدى حوالي تسعمائة سنة، لنتأمّل أي غياب للعقل كان عند ابن النبي نوح؟!
بالمقابل نلاحظ مجموعة من الشباب المقربين من البلاط الروماني في السنوات الأولى من ظهور السيد المسيح نبياً، فقد فضّلوا الإيمان بالله الواحد الأحد، على عبادة انسان مثلهم يحيا ويموت، فسجلوا أروع مثال في التاريخ البشري لـ {إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى}. وكان ما كان من قصة أصحاب الكهف المعروفة لدينا ولدى سائر الاديان السماوية.
والى جانب الاحاديث المروية عن المعصومين عن ضرورة استثمار مرحلة الشباب في العمل والعبادة، وعدم التفريط بها، ثم التحذير من ساعة الوقوف يوم القيامة للحساب على هذه المرحلة العمرية والفرص الذهبية المهدورة. يجدر بنا الإشارة الى تجربة رائعة وناجحة بامتياز حصلت على أرض كربلاء قبل واقعة عاشوراء، عندما سأل الامام الحسين، عليه السلام، ابن أخيه؛ القاسم بن الحسن، عليهما السلام: “كيف الموت عندك”؟! وفي المصادر التاريخية نقرأ أن القاسم كان “شاباً لم يبلغ الحلُم”، يعني ربما كان أقل من الخامسة عشر سنة، فكيف يكون جواب من هو في هذا العمر، على سؤال بهذه الخطورة؟! هنا أرى أن القاسم جسد النجاح بأروع صوره في تحقيق التوازن في معادلة العقل والعاطفة، بقوله: “فيك يا عمّ أحلى من العسل”، فقد أحكم الربط بين الإيمان بحقانية موقفه، والحماس الشبابي، وبين الحب لعمّه والموت دونه.
آلية تحقيق التوازن
ثمة عوامل عديدة من شأنها أن تحفظ للشباب قواهم العاطفية والعقلية لتكون مثل سكتي قطار تحملهم الى آمالهم وأهدافهم في الحياة بسلام، بيد أننا نسلط الضوء على ثلاثة عوامل لها صلة بالواقع الاجتماعي:
العامل الأول: العلم
عندما نقرأ التأكيدات الوافرة في القرآن الكريم، وفي احاديث المعصومين، عليهم السلام، على طلب العلم، تتضح لنا أبعاد مستقبلية لما بعد مرحلة التعلّم، وليس التوقف عند مرحلة اكتساب العلم والمعرفة، والتخرج من الحوزة العلمية او الجامعة –مثلاً- بصفة عالم دين او طبيب او خبير قانوني، إنما يكون طلب العلم مواكباً لحياة الانسان، يستزيده ولا يكتفي منه، ولعل هذا يفسّر وصية النبي الأكرم لنا: “أطلبوا العلم من المهد الى اللحد”.
إن التوقف عند الصفة العلمية يعني هيمنة المشاعر والعواطف على العقل، وتحول هذه الصفة الى مطيّة للشهرة والتفاخر والتعالي على الآخرين، وإن فشل في الحصول على الشهادة الجامعية فانه سيكون حبيس زنزانة اليأس والكآبة، و ربما الانتحار، ومن الافرازات السيئة لهذه الحالة النفسية المتردية؛ البطالة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على البلد، بينما منطق العقل يقول باستمرارية طلب العلم وتحويله الى مسار تقدمي تتخلله التجارب والعمل المستمر لتحقيق نجاحات مستمرة من شأنها تطوير حياة الشباب انفسهم، الى جانب الإسهام في تقدم الاقتصاد والحياة بشكل عام.
ولذا لا نجد في منهج الحوزات العلمية فترة زمنية محددة للدراسة، إنما الفترة ممتدة من عمر الانسان، مع الاخذ بنظر الاعتبار استثمار العلم والمعرفة في مشاريع التغيير والإصلاح وتطوير فكر الانسان ونشر الثقافة والوعي، فمع زيادة العلم والمعرفة يكون صاحبها أكثر قرباً ومحبوبية بين الناس، وأكثر فائدة وتأثيراً في حياتهم.
العامل الثاني: العمل
وما أكثر التأكيدات والتوصيات في الإسلام على العمل بصريح الآيات القرآنية، وصريح الكلام من المعصومين، وفعلهم وتطبيقاتهم العملية بأنفسهم، ثم تأصيل هذا المبدأ في نفس الانسان بالدعوة الى المبادرة، والتنافس، والتعاون حتى أن القرآن الكريم استخدم مفردة “الكدح” الموازية للعمل لمزيد من التحفيز: {يَا أَيُّهَا الإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ}، والآية الكريمة الأخرى تصارحنا مباشرة: {وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ}، والربط هنا واضحاً بين النتائج المادية في الحياة والنتائج المعنوية في الآخرة، وبين حماس الانسان وقدراته العضلية والذهنية، وإيمانه بالله وأنه سيرى ثمار عمله الصالح يوم القيامة، فإن كانت هذه الدعوة للعمل الى جميع افراد المجتمع، فان الشباب سيكونون المقصودين بالدرجة الاولى.
ولنا في رسول الله وأمير المؤمنين، صلوات الله عليهم، أسوة حسنة في العمل بجد دون كلل، مستثمرين كل ساعة في حياتهم لعمل يرون نتائجه في المستقبل، فهذا رسول الله يشارك المسلمين في بناء المسجد، وأمير المؤمنين يستثمر فترة إقصائه من الحكم وممارسة العمل السياسي في مهنة الزراعة، فقد ترك الناس و راح يحرث الأرض بمساحات واسعة في ضواحي المدينة، مستفيداً من قانون الإسلام “الإرض لمن عمرها”، وعلى مدى خمسة وعشرين سنة تمكن الإمام من زراعة النخيل على مساحة تقدر بخمسين هكتار على قياسات الوقت الحاضر، وحفر اربعمائة بئر ماء، وتحولت فيما بعد الى بساتين عامرة بالنخيل، (الشباب- المرجع الديني الراحل السيد محمد الشيرازي).
وثمة احاديث وافرة تحث على الإثراء والغنى المادي تحفيزاً على العمل، على أن الحق في الملكية الفردية من أهم مبادئ الاسلام، وله أحكامه الخاصة في الشريعة، فقد جاء عن رسول الله، صلى الله عليه وآله، “نعم العون على تقوى الله الغِنى”، و روي عن أمير المؤمنين، عليه السلام: “اتّجروا بارك الله لكم فإني سمعت رسول الله، صلى الله عليه وآله، يقول: إن الرزق عشرة أجزاء تسعة في التجارة وواحدة في غيرها”.
إن العمل والنشاط والحيوية تجمع بين ابداع العقل ومشاعر الغبطة والأمل والرضى بنتائج العمل وثماره، بخلاف الكسل والاتكالية، فانها تؤجج مشاعر الغضب والحقد على من يعدهم البعض مسؤولين عن وضع البطالة التي يعيشونها وعدم وجود “تعيينات تكفل لهم الراتب الثابت والمستقبل الآمن”! ومع افتراض تحقق هذا الأمل المنشود عند البعض، كيف يستفيد هذا الشاب من عمله هذا وهو قد غلّب عواطفه ومشاعره على عقله، وجمدت طاقاته الابداعية؟ النتيجة؛ لن تكون الحصول على الوظيفة، إنما اصطحاب حالات نفسية سلبية الى محيط العمل الوظيفي نلاحظها في معظم الدوائر الحكومية خلال التعامل غير السليم مع المواطنين، ولا أجدني بحاجة لأمثلة في هذا المجال.
العامل الثالث: الأخلاق
إنها عصب الحياة الجميلة والسعيدة إن عزم الشباب للوصول اليها، فمهما بلغ الشاب من القوة في المال والعلم والجاه في محيط أسرة ميسورة، فانه لن يستغنِ مطلقاً عما أعمال افراد المجتمع الآخرين الذين سيلتقي بهم يوماً عند حاجته اليهم، وقد أشرنا في مقالات سابقة الى علاقة الأخلاق بالأمن المجتمعي، وفقدان الاحترام بين شرائح المجتمع، وخلق الفجوات الطبقية، يمثل احد الاسباب الرئيسة في نشوء الاحقاد والضغائن في النفوس، ثم حصول الاعتداءات والجرائم.
الإسلام يأتي من البداية ليؤسس لنظام تربوي يوفر للشباب منظومة أخلاقية و آدابية راقية تفيده الى قادم الأيام من حياته ليعيش آمناً معطاءً في محيطه الاجتماعي.
ولا أروع من الخطاب الإلهي للشاب الصغير المملوء حماساً وقوة بأن يحذر من نسيان فضل الأبوين عليه، وأن يحرص على برّهما مهما كانت أحوالهما،وفي سورة الإسراء، يقرن القرآن الكريم بشكل استثنائي بين العبادة والتوحيد لله، وبر الوالدين: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً}.
وفي سورة لقمان ما يغنينا من دروس الأخلاق والآداب الراقية التي تعلمنا كيفية التوازن بين ما يعترينا من غرور الشباب، وبين التفكّر بحقيقة وجودنا بالاساس، وأن الانسان بشكل عام ليس سوى كائن محدود وصغير وعاجز أمام قوانين الطبيعة، وقوانين وسُنن الله –تعالى-.
ختاماً؛ عندما نطرح السؤال فماذا قدم الإسلام والدين للشباب؟ فان الذهن ربما ينصرف الى العطاء المادي، كما تعطي الحكومة للشباب المراكز التعليمية –مثلاً- او المجمعات الرياضية، وحتى المنشآت الانتاجية، وهذا مطلوب وحقّ مسلّم في عنق المسؤولين في الدولة لا شك فيه، إنما العطاء الأكثر ديمومة وصلة بجميع نواحي حياة الشباب، فهو المنهج السليم والمتكامل الذي من شأنه ان يحقق التطلعات والأهداف المرسومة.