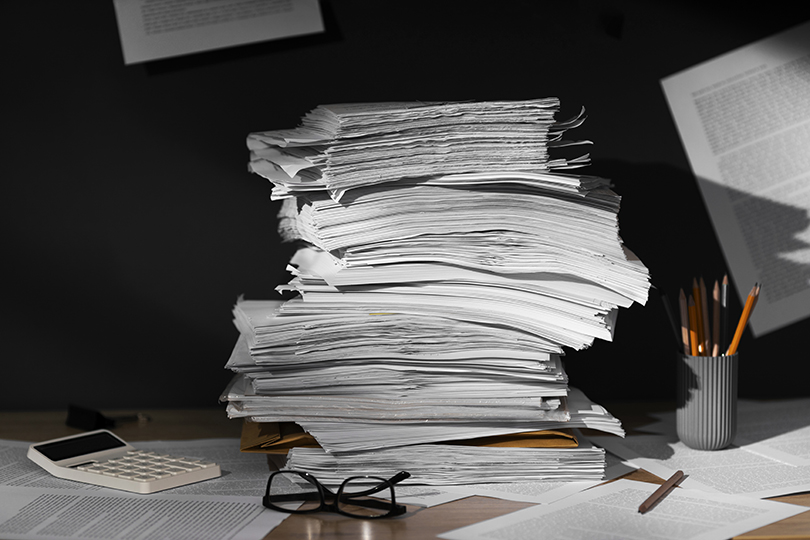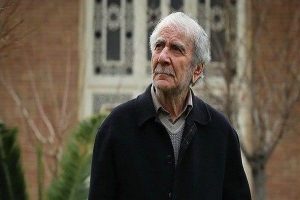ان في الشعر التفكيكي، لا يُطارد الشاعر المعنى ليمسك به، بل يركض خلف ظله، فهو يعرف أن الإمساك به يعني فقدانه. وهنا، تتحول القصيدة إلى مسار احتمالي، لا يُقاس ببلاغة البيان، بل بجرأة الشكّ، وخصوبة المسافة بين اللغة وما لا يُقال…
لقد جاء طرح دريدا للتفكيكية؛ ليعبر عن موقف نقدي من الميتافيزيقا الغربية، ومن انغلاقية البنيوية وتأكيد البنيويين على “أن إغلاق النص هو السبيل الأولى في قراءته” مؤكّداً أن المعنى غير ثابت، وأن النص ينطوي على تناقضاته، ويحوي دائماً أكثر مما يبدو عليه. وما ينتج عن هذه القراءة تأكيد بأن النص يفشل في أن يقول أيّ شيء بشكل قاطع.
وقدّم دريدا مفهوم التفكيك “كاستراتيجية لقراءة النصوص من الداخل، تُظهر أن كل نظام لغوي – مهما بدا صلباً – ينطوي على شروخ داخلية وتناقضات مضمرة. ومن هذا المنطلق، لم يعد المعنى “نهائياً”، بل صار أثراً يتأجل باستمرار، تُطارده القراءة دون أن تمسكه”.
ولكي توضح التفكيكية طبيعة تعاملها مع النصوص فقد أكدت على أن التفكيك ليس طريقة للهدم، بل هو مسعى لفهم النصوص عبر تفكيك بنيتها اللغوية والثقافية، فهي إذن تعبر عن” حركة بنيانية وضد البنائية في الآن نفسه، فنحن نفكك بناءً أو حادثاً مصطنعاً لنبرز بنيانه، أضلاعه، أو هيكله. ونفكك في الآن ذاته البنية الشكلية العارضة والمخربة، التي لا تفسر شيئاً، فهي ليست مركزاً، ولا مبدأ، ولا قوة” كما يقول دريدا.
وفي الشعر، يتحول هذا الموقف إلى تجربة كتابة تُزعزع بنية القول، وتفتّت ثنائيات الحضور والغياب، الذات والآخر، المعنى واللا معنى. إنها إذن كتابة تسير على الحافة.
وهنا لابد أن نشير إلى أن ما أسميناه بـ(الشعر التفكيكي) ليس نمطاً أسلوبياً أو مدرسة فنية بالمعنى التقليدي، بل هو رؤية إلى اللغة والمعنى، وتوتّر دائم مع سلطة الدلالة. إنه امتداد شعري لفلسفة التفكيك التي أسسها جاك دريدا، ولكنه لا يقف عند حدودها الفلسفية، بل يتجلّى في التجربة الشعرية بوصفها لعبة مفتوحة في حقل اللايقين.
وهو ليس شعراً (غامضاً) أو (مجرداً) فحسب، بل هو شعر: لا يثق في اللغة كأداة تمثيل. ولا يطمئن إلى المعنى الواحد. ويكتب الذات بوصفها مسرحاً للتفكك والانشطار. إنه لا يبحث عن “رسالة”، بل عن احتمال المعنى، عن ذلك الظلّ الذي يتكوّن من تنافر الكلمات، ومن توتر النحو، ومن اللعب الحادّ بالبنية.
وما نقصده بالمجرد: هو ذلك الشعر الذي يجنح إلى التجريد أي الابتعاد عن التشخيص والمحسوسات، ويتجه إلى الأفكار والنظريات والمفاهيم العامة، مبتعداً عن الصور الحسية والمشاهد الواقعية.
في هذا النمط من الشعر وفي إطار عملية تفكيك الثنائيات كثيراً ما يتم قلب الثنائيات الكبرى في القصيدة، فالصمت يتكلم، والموت يُكتب كولادة، والأنوثة تُنسف كهوية مستقرة.
وفي إطار تفجير البنية، تتخلى القصيدة عن التسلسل أو التماسك الشكلي، وتُقدِّم بدله تشظياً واعياً يُربك التلقي.
ولكي تنجز عملية اللعب بالضمائر والزمن، فإن القصيدة تُكتب في حاضر غامض، أو يُحرّف فيها الضمير فجأة دون إحالة واضحة، ما يجعل هوية المتكلم والمخاطب موضع سؤال دائم.
ولكي تؤكد اللايقين الدلالي فإنها تترك العبارات مفتوحة؛ لتتعدد إحالاتها، و تنقض بعضها بعضاً، في صراع خفي بين القول ونقيضه.
والشعر التفكيكي واقعاً لا يرفض المعنى، بل يفضح هشاشته، ويعيد صياغة علاقتنا باللغة بوصفها بيتاً لا مأوى فيه. وهذا ما يرسم لنا صورة بارزة للتقاطعات العميقة مع تصورات النقد الاحتمالي، الذي ينظر إلى النص باعتباره حقلاً دينامياً من التأويلات الممكنة، لا وثيقة ذات دلالة مغلقة.
إن الشاعر التفكيكي لا يكتب ليُعبّر، بل ليُشكك، وليفتح نافذة في الجدار، أو ليرسم جداراً في الهواء.
وهذا ما يمكن أن نجد له أمثلة في العديد من نصوص أدونيس، الذي كثيراً ما يُمارس التفكيك عبر زعزعة الثنائيات التاريخية والدينية، ويتقصد الكتابة في فضاء مجهول الذات والمآل.
كما يمكن أن نجد تمثلات ذلك أيضاً في ديوان “الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع” لأنسي الحاج، حيث تفكّكت الهوية في القصيدة إلى حدّ أن الكتابة نفسها صارت موضوعاً للحبِّ والفقد.
وكذلك نجده في بعض نصوص سركون بولص، وسنأخذ مقطعاً من نص له بعنوان (عظمة أخرى لكلب القبيلة) لنحاول قراءته في ضوء المنهج التفكيكي كمثال استدلالي على ذلك، يقول بولص: (تحت نور الفجر المتدفّق من النافذة،/ كانَ حذاؤهُ الضخم ينعسُ مثل سُلحفاة زنجيّة./ كان يُدخّن، يُحدّقُ في الجدار/ ويعرفُ أنّ جدراناً أخرى بانتظاره عندما يتركُ البيت/ ويُقابلُ وحوشَ النهار، وأنيابَها الحادّة. /لا العَظمة، تلك التي تسبحُ في حَساء أيّامه كإصبع القدَر/ لا، ولا الحمامة التي عادت إليه بأخبار الطوَفان.)
1. تفكيك صورة الإنسان والبطولة
التشبيه بالسلحفاة الزنجية يحمل حمولة ثقافية وتاريخية تفكك “مركز” الإنسان الأبيض أو القوي أو “السيد”.
تفكيكياً: الإنسان هنا ليس سيد الموقف، بل كائن هامشي، متعب، خامل، عالق في بطء سلحفائي، في انعكاس عكسي لصورة البطولة.
2. اللعب باللغة والانزياح الدلالي
الجدران هنا ليست حدوداً بل أفخاخاً أخرى، والعالم ليس فسحة للحرية، بل سلسلة متصلة من الحواجز. فالنص هنا يزعزع التوقعات الدلالية: فالبيت ليس ملجأً، والخروج منه لا يؤدي إلى انفتاح بل إلى جدران أخرى، إلى حصار مضاعف.
3. تفكيك النهار كرمز للحياة
عادةً ما يرمز النهار إلى النور والانفتاح والحياة. ولكن سركون يقلب هذه الدلالة من خلال تحويله إلى وحش يلتهم الإنسان، إلى تهديد لا إلى خلاص.
وهو ما ينتج عنه انهيار الثنائية التقليدية (نهار = أمان، ليل = خطر) واستبدالها بتجربة عدوانية حيث لا توجد جهة مطمئنة.
فالعالم إذن عند سركون نصٌّ مفكك لا يقبل قراءة واحدة، نصٌّ يفضح هشاشة الكينونة واللغة معاً، ويقيم احتفالاً سوداوياً بانهيار المراكز.
إن إشارتنا لهؤلاء الشعراء ليس من باب الحصر ولكن من باب التمثيل، كما أن هذا التحديد النمطي للشعر لا يعني تقييد القراءة وفق المنهج التفكيكي بشعر هؤلاء أو غيرهم، وإنما القصد من ذلك هو الإشارة إلى توظيف هؤلاء آليات المنهج في تلك النصوص.
وأخيراً يجدر أن نؤكد أن في الشعر التفكيكي، لا يُطارد الشاعر المعنى ليمسك به، بل يركض خلف ظله، فهو يعرف أن الإمساك به يعني فقدانه. وهنا، تتحول القصيدة إلى مسار احتمالي، لا يُقاس ببلاغة البيان، بل بجرأة الشكّ، وخصوبة المسافة بين اللغة وما لا يُقال.