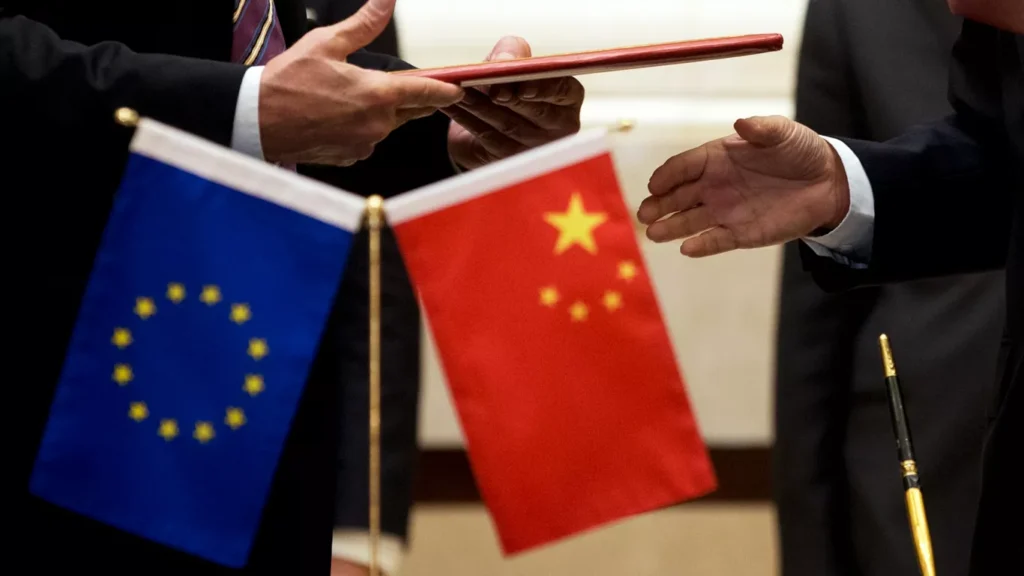في ظل مشهد دولي مضطرب، تغلي فيه التوترات وتعيد الدول رسم خرائط النفوذ والتأثير، يلتقي الاتحاد الأوروبي والصين في قمة تاريخية تُعقد في العاصمة بكين، فيما تُعلَن الذكرى الخمسين للعلاقات الدبلوماسية بينهما. هذا اللقاء، الخامس والعشرون من نوعه، لا يأتي في سياق طبيعي أو دبلوماسي تقليدي، بل في ظل تقاطعات حادة وتباينات عميقة بين قوتين تسعى كل منهما إلى ترسيخ موقعها في عالم ينفض عن نفسه نظامًا عالميًا تقليديًا، ويتجه بخطى سريعة نحو صياغة جديدة لموازين القوى العالمية.
تبدو بكين اليوم أكثر استعدادًا لقيادة شرق عالمي جديد، بينما تبدو بروكسل في حيرة من أمرها، تبحث عن توازن بين حماية القيم الليبرالية الغربية، والاندماج الضروري في منظومة المصالح الاقتصادية التي تُمثل الصين قطبها الأبرز. ما يجعل هذه القمة مفصلية، ليس فقط في تحديد شكل العلاقة الثنائية، بل في صياغة ملامح النظام العالمي الذي لم يعد يحتمل الترف الأيديولوجي، بل يقدّم المصالح أولًا في قائمة الأولويات.
أوروبا في المأزق الثلاثي؛ روسيا وواشنطن وبكين
حين خرج ترامب من البيت الأبيض قبل سنوات، تنفست أوروبا الصعداء. لكنها ما لبثت أن وجدت نفسها أمام عودته المتوقعة، محمّلًا بنزعة انعزالية صارمة وبرغبة جامحة في إعادة ترتيب أوراق السياسة الدولية، بما يتلاءم مع المصالح الأميركية الضيقة. في المقابل، دخلت العلاقة الأوروبية الروسية مرحلة اللاعودة، بعد الحرب الأوكرانية، وانهارت جسور التواصل التي كانت قائمة ضمن صيغة “الجار الشرقي المزعج”.
أمّا الصين، فهي وإن كانت على طرف نقيض من النموذج السياسي الأوروبي، فإنها تحتفظ بورقة مهمة يصعب التفريط فيها وهي التجارة. في هذا السياق، تجد أوروبا نفسها أمام واقع جديد، لا يمكن فيه استمرار العلاقة الوثيقة بالولايات المتحدة، دون دفع أثمان اقتصادية مرهقة، ولا يمكن فيه أيضًا التنازل الكامل أمام الصين دون مواجهة تمرد داخلي أوروبي على القيم والمبادئ التي تشكل جوهر الهوية الغربية. مأزق حقيقي يدفع بروكسل إلى محاولة هندسة مواقف أكثر مرونة، تتماهى مع المصالح من دون التخلي التام عن المبادئ.
الصين.. التوسّع على أنقاض الانقسامات الغربية
منذ بداية القرن الحادي والعشرين، لم تتوقف الصين عن رسم ملامح قوتها الصاعدة من مصانع عملاقة، شركات متعددة الجنسيات، تطور تكنولوجي، وبنية تحتية عالمية تنسجها عبر مشروع “الحزام والطريق”. ومع صعود شي جين بينغ، باتت بكين أكثر وضوحًا في إعلان طموحاتها: ليست فقط قوة اقتصادية، بل قوة سياسية وثقافية تسعى لإعادة تشكيل العالم وفق رؤيتها.
ترى الصين في الاتحاد الأوروبي كيانًا غير متجانس، تغلب عليه النزاعات الداخلية والولاءات المتذبذبة للولايات المتحدة. وهذا يجعل بكين تنظر بشيء من الاستعلاء والتوجّس إلى بروكسل، التي تعجز عن اتخاذ موقف موحد في قضايا مفصلية مثل تايوان، حقوق الإنسان، أو التجارة العادلة.
ومع ذلك، فإن القيادة الصينية لا تمانع في مد جسور التعاون مع أوروبا، شرط أن تبنى على أسس المصالح المتبادلة، وأن تُغضّ الطرف، ولو مؤقتًا، عن المعايير الليبرالية التي تحبّ أوروبا التشبث بها.
أين تختبئ العدالة الاقتصادية؟
أرقام الميزان التجاري بين الطرفين تكشف عن واقع مقلق لأوروبا من عجز سنوي يتجاوز 400 مليار يورو، لصالح الصين. ورغم أن هذا يعكس التنافسية العالية للصناعة الصينية، إلا أنه يطرح أسئلة حادة حول عدالة التبادل التجاري بين قوتين يفترض أنهما تتقاسمان قواعد منظمة التجارة العالمية.
تتحدث أوروبا عن دعم حكومي صيني غير شفاف، وعن إغراق الأسواق الأوروبية بالسيارات الكهربائية والمنتجات المدعومة، في حين تواجه الشركات الأوروبية صعوبات جمّة في دخول السوق الصينية، المليئة بالحواجز التنظيمية والمنافسة غير المتكافئة. تحاول بروكسل معالجة هذا الخلل عبر إجراءات حمائية، مثل فرض رسوم جمركية، وتتبع تدفقات السلع الصينية، لكنها تعرف أن أي خطوة غير مدروسة قد تؤدي إلى حرب تجارية، هي في غنى عنها، في وقت تشهد فيه سلاسل الإمداد العالمية اختناقات غير مسبوقة.
المعادن النادرة.. سلاح بكين الاقتصادي
من بين الأوراق التي تمسك بها الصين بحزم، يبرز ملف المعادن النادرة، الذي يكاد يكون سلاحًا استراتيجيًا في يد بكين. أوروبا تعتمد بنسبة 98% على الصين للحصول على هذه المواد الحيوية لصناعاتها التكنولوجية والطبية والخضراء، وتلقت ضربة قوية العام الماضي حين قررت بكين تقليص صادراتها بنسبة 84%، لأسباب قالت إنها “تتعلق بالأمن القومي”.
هذه الخطوة أشعلت الغضب الأوروبي، الذي اعتبرها ابتزازًا اقتصاديًا، ومحاولة لتوظيف التجارة في الصراع السياسي. لكن الصين، وعلى طريقتها، ردّت باتهام الأوروبيين بأنهم يمارسون “حمائية مموّهة” عبر استبعاد الشركات الصينية من القطاعات الاستراتيجية، وتطبيق آليات تدقيق تعسفية.
في هذا الملف، يكمن جوهر التوتر بين المصالح والأيديولوجيا، أوروبا تريد الشفافية والوصول الحر، والصين تريد السيادة الاقتصادية والحذر من أي اختراق أوروبي سياسي محتمل.
الطاقة المتجددة.. معضلة “الإغراق المفيد”
رغم التوترات، لا تستطيع أوروبا الاستغناء عن المنتجات الصينية في مجال الطاقة النظيفة، الألواح الشمسية، البطاريات، التوربينات… كلها تُنتج بكفاءة عالية وأسعار منخفضة، وتشكّل حجر الأساس في استراتيجية أوروبا لتحقيق الحياد الكربوني.
لكن كيف يمكن لأوروبا أن توفق بين حماية صناعتها المحلية، وبين الاستفادة من تفوق الصين في هذه المجالات؟ شركات مثل “BYD” الصينية بدأت تبني مصانعها في قلب أوروبا، ما يطرح معضلة معقدة: هل وجود هذه الشركات داخل القارة الأوروبية يخفف وطأة الإغراق؟ أم أنه يشكّل اختراقًا صناعيًا يهدد الصناعات المحلية؟ هذه التساؤلات قد تُطرح في هذه القمة بالذات.
التحولات الجيوسياسية.. صياغة المستقبل
لم تعد القمم الدولية تُعقد فقط لمناقشة القضايا الثنائية، بل أصبحت منصات لرسم مستقبل العالم في ظل تآكل فعالية المؤسسات الدولية وانحدار النظام الليبرالي التقليدي. أوروبا، التي ترى نفسها وريثة الحداثة السياسية، باتت اليوم عاجزة عن فرض إرادتها، في ظل صعود قوى جديدة لا تؤمن بقواعد اللعبة القديمة.
وفي هذا السياق، تحاول بروكسل دفع الصين نحو الانخراط في إصلاح النظام الدولي المتعدد الأطراف، بدلاً من تقويضه أو العمل على استبداله. هل تنجح في ذلك؟ الأمر لا يتوقف فقط على النوايا، بل على مدى قدرة أوروبا على تقديم عرض مغرٍ لبكين، يضمن مصالحها ويعطيها دورًا فاعلًا دون أن يهدد سيادتها السياسية أو نماذجها الاقتصادية.
الحرب الأوكرانية.. ورقة ضغط أم نقطة انفجار؟
سيكون من المستحيل تجنب طرح ملف الحرب في أوكرانيا في القمة، خصوصًا في ظل الاتهامات الأوروبية للصين بأنها تدعم روسيا اقتصاديًا وسياسيًا، وتوفّر لها مخرجًا من العقوبات عبر مشتريات الطاقة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج.
لكن الواقع يُظهر أن بكين لا ترى في روسيا حليفًا طارئًا، بل جزءًا من منظومة استراتيجية لمواجهة الضغط الغربي المتمثل في واشنطن وبروكسل معًا. لذا، فإن محاولات أوروبا لإقناع الصين باتخاذ موقف أكثر توازنًا، تصطدم بجدار من الواقعية السياسية الصينية، التي تعطي الأولوية لمصالحها الإستراتيجية على أي اعتبارات أخلاقية أو إنسانية.
هل القمة استعراض قوة صيني؟
اختارت بكين أن تكون القمة مقتضبة، يومًا واحدًا فقط، وفي العاصمة الصينية بدلًا من بروكسل، وهذا القرار لم يأتِ من فراغ. إنه انعكاس مباشر لتراجع سقف التوقّعات، ولربما استعراض محسوب من الصين لقوتها وامتلاكها زمام المبادرة. حين تُقلَّص القمم ويُعاد ترتيب مكان انعقادها، فإن ذلك يحمل رمزية سياسية أكثر مما يبدو. بكين تفرض مساحتها الرمزية، وتُبعد بروكسل عن ملعبها التقليدي، وتدعوها إلى اللقاء حيث تشعر هي بثقة أكبر، وحيث تخاطب العالم من مركزها الحضاري، لا من هامش توازنات الآخرين.
لكن هذا التقليص لا يلغي أهمية القمة، بل يؤكد أن كل طرف على مفترق طرق: الاتحاد الأوروبي يستشعر ضياع بوصلته الدولية في ظل عداء مع موسكو وتراجع الحماية الأميركية، أما الصين فتواجه ضغطًا غير مسبوق من منظومة الغرب، وتحاول عبر الحوار تجنّب الانزلاق نحو مواجهة شاملة قد تعزلها دوليًا وتكلفها اقتصاديًا.