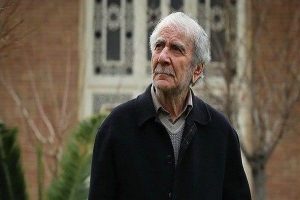العقل لا يتطور صدفة، ولا تُبنى الشخصيَّة القويَّة بالعاطفة وحدها، ولا تُنتج العقول أفكارًا ناضجة في بيئة مشتتة أو من مصدر واحد؛ وإنَّما القراءة هي البذرة، والتَّحقيق هو الغربال، وتنوع المصادر هو الماء، وأمَّا التَّركيز فهو أشعة الشَّمس التي تمنح الفكرة نضجها وقوَّتها. من أراد عقلًا حُرًا، وفكرًا ناضجًا…
في عالمٍ يضجُّ بالمعلومة، لا يُمنَح التَّفوّق لمن يعرف أكثر؛ وإنَّما لمن يفكِّر بعمق، ويتحرَّك بوعي، ويختار مصادره بعناية، ويمنح أفكاره حقَّها من التَّركيز والنُّضج.
لقد تحوَّلت المعرفة من كنز نادر إلى طوفان جارف؛ لكن العقول الواعية وحدها قادرة على التَّمييز بين الوميض الخادع والنُّور الحقيقي. فلا تكفي سرعة الوصول إلى المعلومة، إن لم نكن نُحسن قراءتها، ولا يكفينا حفظها إن لم نُحسن التَّحقيق فيها، ولا يُغني تكرارها ما لم نُحسن التَّنوّع في مصادرها، ولا تثمر فكرة إن لم نُحسن التَّركيز عليها حتَّى تنضج وتؤتي أُكُلها.
ها هو دربُ صياغة الذَّات وتشييد الفكر… مسارٌ ينطلق من كتاب، ويحييه السُّؤال، وتغنيه المصادر، ويزهو بالتَّركيز.
فهل أعددت نفسك لخوض هذه الرِّحلة؟
كي تكتشف خباياها؛ فإن كنت كذلك، فلنشرع بكشفها سرًّا تلو سر:
السر الأوَّل: القـــراءة والمطالعـــة
القراءة والمطالعة تفتح آفاقًا واسعةً؛ إذ تشاركُ من خلالها عقولَ الآخرين؛ فالكتابُ هو جزءٌ من عقل إنسانٍ آخر، يعبر بوجوده الكتبي عن وجوده العقلي الذي تجسَّد في تلك الكلمات، وحينما نقرأ فإننا في الحقيقة نشارك الآخرين في أفكارهم وعقولهم، وهذا يفتح أمامنا آفاقًا لا حصرَ لها.
إنَّ القراءة والمطالعة تشكِّل جزءًا أساسيًا من حياة الإنسان الطَّموح؛ فهي النَّافذة التي يطل من خلالها على عوالم مختلفة من المعرفة والحكمة. كما أنَّها تعمل على توسيع مدارك الإنسان وتزويده بالمعرفة، ويتعدَّى ذلك إلى بناء فكره ونضج أفكاره وتطوير قدراته العقليَّة على مستويات متعدِّدة؛ لأنَّ القراءة تغذِّي العقلَ بمعلومات متنوعة، ممَّا يساعد على تنمية الوعي والإدراك لدى الإنسان، وعندما ينخرط الفرد في القراءة، فإنَّه يدخل في تفاعل مع الأفكار والمعارف المطروحة في النُّصوص التي يقرأها، وهذا التَّفاعل ينتهي إلى تحفيز العقل على التَّفكير النَّقدي والتَّحليلي، ممَّا يمكِّن الفرد من فحص وتحليل المعلومات المطروحة، والتَّفكير في مضمونها من زوايا متعددة، ومع مرور الوقت تتراكم هذه المهارات الفكريَّة لتشكِّل ركيزة أساسيَّة لنضج الأفكار وقدرة العقل على التَّعامل مع المفاهيم المعقَّدة بمرونة وكفاءة.
إلى جانب ذلك، فإنَّ القراءة تشارك في تحسين القدرة على التَّركيز والانتباه، وهذا التَّدريب المستمر على التَّركيز والانتباه يزيد من قدرة العقل على التَّعامل مع المعلومات بشكل فعَّال، ويساعد على تحسين أداءِ العقل في مهام أخرى.
ومع زيادة القراءة، يصبح الفرد أكثر قدرة على التَّعبير عن أفكاره بوضوح ودقَّة، سواء في الكتابة أو في التَّحدث، وهذا التَّحسن في مهارات التَّواصل يرفع من قدرة الفرد على التَّعامل بشكل فعَّال مع الآخرين، سواء في الحياة الشَّخصيَّة أو المهنيَّة أو الاجتماعيَّة.
في عالمنا الحديث؛ الذي يمتلئ بالضُّغوط والإجهاد، يمكن أن تكون القراءة وسيلة للتخلص المؤقت من الواقع والدخول في عالم مختلف، وهذا يساعد العقل على الاسترخاء، ويتيح له فرصة للراحة والتَّجدد؛ لأنَّ القراءة توفر للعقل مساحة للتَّركيز على شيءٍ مختلف بعيدًا عن المشاكل والضُّغوط اليوميَّة، ممَّا يمكِّنه من العودة إلى الواقع بنظرة أكثر إيجابيَّة.
لقد منح الإسلامُ القراءةَ مكانةً سامية، وجعلها مفتاحًا للوعي وبابًا للفلاح، حتَّى كانت أوَّل كلمة خوطب بها النَّبي (صلَّى الله عليه وآله) من السَّماء أمرًا بالقراءة؛ إذ قال (تعالى): (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ) وفي هذه الكلمات الأولى من الوحي، يتجلَّى نداء السَّماء إلى الأرض بضرورة أن تكون المعرفة نقطة البداية، وأن يكون الكتاب سُلَّم الارتقاء، والعلم طريق النُّهوض بالحضارة وبناء المجتمعات؛ ولأنَّ القراءة في بعض صورها عبادة تُزكِّي النَّفس وتُنير البصيرة، جاءت النُّصوص الشَّريفة لتؤكِّد على فضل القراءة في المصحف نظرًا، فقد روي عن الإمام جعفر الصَّادق (عليه السلام) قوله: “مَنْ قَرَأَ الْمُصْحَفِ نَظَراً مُتِّعَ بِبَصَرِهِ وَخُفِّفَ عَلَى وَالِدَيْهِ، لَيْسَ شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الْمُصْحَفِ نَظَرًا”. وهنا تمتزج بركة الحرف بصفاء العين، لتتحوَّل القراءة إلى نور يملأ البصر، ويخفِّف الأوزار، ويقهر الشَّيطان.
وكما اهتمَّ الإسلام بعمارة العقل بالقراءة، فقد أولى التَّفقه في الدِّين منزلة عظيمة، حتَّى خصَّ يوم الجمعة بكونه فرصة للتزوّد من الفقه بمعناه الواسع؛ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ آبَائِهِ (عليهم السلام)، قَالَ: “قَالَ رَسُولُ الله (صلَّى الله عليه وآله): أُفٍّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ لاَ يَجْعَلُ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ يَوْماً يَتَفَقَّهُ فِيهِ أَمْرَ دِينِهِ وَيَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ” . وهكذا تلتقي القراءة بالفقه في مسار واحد؛ مسارٍ يصوغ شخصيَّة المؤمن الواعي، الذي يجمع بين نور المعرفة ونور الهداية، ليكون لبنة صلبة في بناء الأمَّة ورسالتها.
السر الثَّاني: التحقيق في المعلومة
في حياتنا اليوميَّة، نواجه الكثيرَ من المواقف التي تتطلَّب منَّا اتِّخاذ قرارات بناءً على معلومات معيَّنة، وغالبًا ما نقبل هذه الأمور كما هي دون أن نتساءل أو نحقق في دقَّتها، وقد يكون ذلك نتيجة للعادة أو الثِّقة في المصادر التي تقدِّم لنا هذه المعلومات؛ أو ربما لأننا لا نمتلك الوقت أو القدرة على التَّحقق، ولكن مع ازدياد كميَّة المعلومات التي نتعرَّض لها يوميًا، يصبح من الضَّروري أن نتعلَّم كيفيَّة التَّعامل معها بذكاء ونقد، وألَّا نقبلها بلا تحقيق. وهنا يبرز دور التَّفكير النَّقدي والتَّحقيق كأداتينِ أساسيتينَِ لحماية أنفسنا من الوقوع في فخاخ التَّضليل وسوء الفهم، وأمَّا قبول الأمور كما هي من غير تحقيق قد يقودنا إلى تكوين معتقدات وأفكار خاطئة تؤثِّر بشكلٍ سلبي على حياتنا وقراراتنا، وفي بعض الأحيان، يمكن أن ينتهي عدم التَّحقيق إلى تبني مواقف أو اتِّخاذ قرارات قد تكون لها تأثيرات سلبيَّة على النَّفس وعلى الآخرين وعلى المجتمع بشكل عام.
ويُعرف التَّفكير النَّقدي بأنَّه القدرة على تحليل المعلومات والادِّعاءات بدقَّة، والتَّأكد من صحَّتها قبل تبنيها؛ وطريق ذلك عندما نتعامل مع معلومةٍ أو موقفٍ ما، علينا أن نسأل أنفسنا بعض الأسئلة الضروريَّة:
ما هو مصدر هذه المعلومة؟
وهل يمكن الاعتماد عليه؟
وهل هناك أدلة تدعم هذه الادعاءات؟
علينا أن ندرك أنَّ الكثير من المعلومات التي نتلقاها قد تكون غير دقيقة أو مغلوطة؛ ففي عصر التّكنولوجيا الحديثة أصبح من السَّهل نشر المعلومات بسرعة؛ ولكن منْ يدقق سيجد أنَّ العديد من المعلومات المتداولة عبر وسائل التَّواصل الاجتماعي قد تكون مضللة؛ لذا، يصبح التَّحقيق في صحَّة المعلومات أمرًا ضروريًا للحفاظ على سلامة عقولنا ومعرفتنا. وينبغي الالتفات إلى أنَّ التَّحقيق عمليَّة تتطلَّب الصَّبر والجهد؛ ففي بعض الأحيان، قد يستغرق التَّحقيق وقتًا وجهدًا كبيرينِ، خصوصًا إذا كانت المعلومات معقَّدة أو متشابكة، لكن هذا الجهد لا يذهب سدىً، فهو يمنعنا من الوقوع في الأخطاء أو اتِّخاذ قرارات غير مدروسة، كما يساند التَّحقيق قدرتنا على فهم الأمور بشكل أفضل، ويمنحنا الثِّقة في صحَّة ما نؤمن به.
لا يعني التَّحقيق دائمًا السَّعي وراء الحقيقة المطلقة، ويمكن أن يكون وسيلة لفهم الأمور بعمق ودقَّة أكبر؛ فأحيانًا قد لا نصل إلى اليقين التَّام، لكن يمكننا تقليل الشُّكوك وتحسين مستوى الفهم، وهذا بحدِّ ذاته يمثِّل تقدمًا مهمًا.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسهم التَّحقيق في تطوير مهاراتنا العقليَّة وقدرتنا على التَّفكير النَّقدي والتَّحليلي، وعندما نتعلَّم كيف نحقق في المعلومات ونفكِّر بشكلٍ نقدي، نصبح أكثر قدرة على التَّعامل مع التَّعقيدات والاختلافات في الحياة، وهذا بدوره يجعلنا أكثر قدرة على مواجهة المواقف الصَّعبة وتبني الأحكام الصَّائبة في ظلِّ ظروف عدم اليقين.
قد نشعر في بعض الأحيان بالضَّغط الاجتماعي لقبول الأمور كما هي من غير تحقيق، وقد نواجه ضغوطًا من الأصدقاء أو الزُّملاء أو حتَّى من المجتمع لتبني مواقف معيَّنة أو قبول معلومات مع عدم التَّشكيك فيها؛ لكن من المهم أن نتذكَّر أنَّ التَّفكير النَّقدي والتَّحقيق هما جزء من مسؤوليتنا الفرديَّة، ويجب أن نكون مستعدين لمواجهة هذه الضُّغوط والدِّفاع عن حقِّنا في التَّساؤل؛ فإننا حينما نقبل الأمور كما هي، نسمح للآخرين بالتَّأثير على أفكارنا ومعتقداتنا، وهذا التَّأثير قد يكون إيجابيًا في بعض الأحيان؛ لكنه قد يكون سلبيًا في أحيان أخرى.
نعم، ليس المطلوب أن نشكك في كلِّ شيءٍ باستمرار؛ فهناك أمور تستحق الثِّقة والتَّبني، حتَّى وإن لم نحقق فيها، خصوصًا إذا كانت مدعومة بأدلة قويَّة وموثوقة؛ ولكن في نفس الوقت، ينبغي أن نكون دائمًا مستعدين للتحقيق والتَّساؤل عندما تظهر معلومات جديدة أو عندما نشعر بالشَّك.
السر الثَّالث: خطورة الاعتماد على مصدر واحد
في عصر المعلومات الذي نعيش فيه اليوم، أصبح الوصولُ إلى المعرفة أمرًا سهلًا وسريعًا بفضل الإنترنت والتّكنولوجيا الحديثة؛ إذ يمكن لأيّ شخص الوصول إلى كمٍ هائل من المعلومات في غضون ثوانٍ قليلة من خلال البحث على محركات البحث أو زيارة مواقع التَّواصل الاجتماعي، ومع ذلك، يواجه المستخدمون صعوبات كبيرة في التَّمييز بين المعلومات الصَّحيحة والمغلوطة؛ إذ يمكن لأيّ شخص نشر معلومات من دون رقابة أو تحقق من صحتها، ومن هنا تنبع أهميَّة التَّحقق من المعلومات من خلال مصادر متعدِّدة وعدم الاعتماد على مصدر واحد فقط.
قد نقع في فخ الاعتماد على المصدر الأوَّل الذي يظهر لنا عندما نبحث عن المعلومة. وهذا المصدر قد يكون موثوقًا وقد يكون غير دقيق؛ لذا، من الضَّروري أن نتأكد من صحَّة المعلومة عن طريق الرُّجوع إلى مصادر أخرى، والتَّحقق من المعلومة؛ وهذا يوفِّر لنا منظورًا أكثر شمولًا ويساعد على تقليل احتمالية الوقوع في الخطأ أو التَّلاعب بالمعلومات.
إنَّ تعدد المصادر يساعد في تأكيد المعلومة، ويعطينا أيضًا فهمًا أعمق للموضوع، وعلى سبيل المثال، إذا كنت تبحث عن معلومات حول حدث تاريخي معيَّن، فإنَّ قراءة تقارير أو مقالات من زوايا مختلفة يساعدك في تكوين صورة كاملة ودقيقة لهذا الحدث؛ فبعض المصادر قد تقدِّم تفاصيل غائبة، أو قد تقدِّم تحليلًا أو تفسيرًا مختلفًا يمكن أن يضيف إلى معرفتك وفهمك للموضوع؛ ولذلك من أكبر المخاطر التي نواجهها اليوم هو انتشار المعلومات المضللة أو الأخبار الكاذبة؛ ومع أنَّ الأخبار الزَّائفة والمعلومات المضللة ليست مشكلة جديدة؛ لكنها أصبحت أكثر انتشارًا في العصر الرَّقمي؛ فكثيرٌ من النّاس يشاركون المعلومات عبر وسائل التَّواصل الاجتماعي؛ ولكنهم لم يتعبوا أنفسهم في التَّحقق من صحتها، وهذا يمكن أن يسفر عن انتشار واسع للمعلومات الخاطئة؛ وفي بعض الأحيان، قد تكون هذه المعلومات ضارَّة بشكلٍ كبيرٍ، خاصَّة إذا كانت تتعلَّق بدين الإنسان وصحَّته أو السِّياسة التي تحكمه.
والأمثلة على ذلك كثيرة خاصَّة في مواسم الانتخابات التي تحدد مصير الشُّعوب؛ في الوقت الذي تنتشر الكثير من الأخبار الكاذبة على وسائل التَّواصل الاجتماعي، وهذه الأخبار تشارك في تشكيل الرَّأي العام بطريقة أو بأخرى، وبعض هذه الأخبار من الصَّعب التَّحقق من صحَّتها إذا اعتمد الشَّخص على مصدر واحد فقط، ولكن عند البحث عن نفس الموضوع في مصادر أخرى من الممكن اكتشاف التَّناقضات وفهم الحقيقة بشكلٍ أفضل.
ومثال آخر يمكننا النَّظر إليه هو مرض (كورونا جائحة كوفيد-19)؛ إذ انتشرت في بداية الجائحة الكثير من الشَّائعات والمعلومات الخاطئة حول الفيروس وكيفيَّة انتقاله والعلاج منه، والعديد من الأشخاص الذين اعتمدوا على مصادر وحيدة، سواء كانت وسائل التَّواصل الاجتماعي أو مواقع غير موثوقة، قد تأثَّروا بتلك المعلومات ممَّا أدَّى إلى تصرفات غير مناسبة أو حتَّى ضارة.