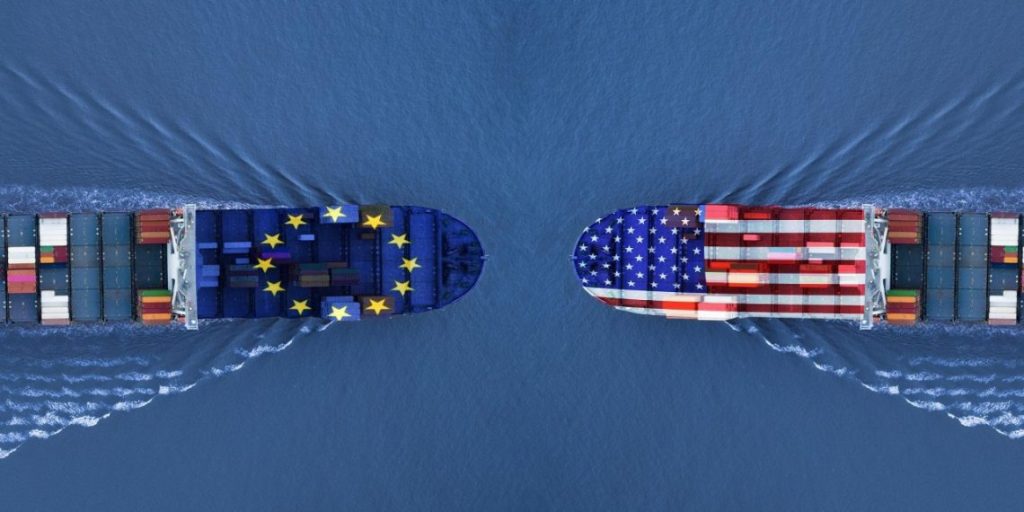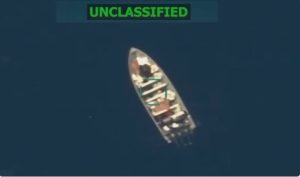في صيفٍ سياسيٍّ ساخن، وبين أمواج الأزمات المتلاحقة، تخرج صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية بتقريرٍ مثيرٍ للجدل، يكشف هشاشة الموقف الأوروبي في مواجهة الولايات المتحدة، ويطرح تساؤلات عميقة حول قدرة الاتحاد الأوروبي على خوض حرب تجارية، أو حتى الدفاع عن مصالحه المشتركة. التقرير لا يكتفي بعرض الوقائع، بل يغوص في عمق التناقضات البنيوية التي تعاني منها أوروبا، من الانقسام السياسي إلى التبعية الاقتصادية، ومن العجز العسكري إلى غياب الرؤية الجيوسياسية الموحدة.
كيف رضخت أوروبا لصفقة ترامب؟
حين تتحدث «فايننشال تايمز» عن رضوخ أوروبا لغرائز دونالد ترامب، فهي توثق لحظة سياسية تُجسّد الضعف الأوروبي أمام قرارات منفردة اتخذتها واشنطن. لقد اضطر الاتحاد الأوروبي إلى القبول بسلسلة من التنازلات، تبدأ بزيادة الإنفاق العسكري لحلف «الناتو»، مروراً بتمويل متطلبات أوكرانيا التسليحية، ووصولاً إلى استسلامه أمام الرسوم الجمركية التي فرضتها أميركا دون استشارة أو تنسيق، وكأن أوروبا فقدت قدرتها على المواجهة الجماعية.
ليس الأمر مجرد علاقات تجارية غير متوازنة، بل هو انعكاس لفقدان التوازن في العلاقات الدولية نفسها. في خضم هذه الأزمات، تكتفي أوروبا بردود فعل خجولة، وتُغدق على الولايات المتحدة تعهدات بالشراء والاستثمار، فيما تتحمل شعوبها وطأة التضخم وتراجع السيادة الاقتصادية.
الاتحاد الأوروبي مجرد شعار
منذ تأسيسه، حمل الاتحاد الأوروبي وعودًا كبيرة: وحدة اقتصادية، قوة سياسية مشتركة، وسوق موحدة تضمن الازدهار لجميع الدول الأعضاء. لكن الواقع السياسي اليوم يُظهر صورة مختلفة تمامًا. فبدلًا من أن يكون الاتحاد مظلة جامعة، بات يعاني من انقسامات داخلية تُضعف قدرته على اتخاذ قرارات حاسمة، خصوصًا في الملفات الكبرى مثل الدفاع، الطاقة، والسياسة الخارجية.
التقرير الصادر عن «فايننشال تايمز» يُسلّط الضوء على هذه الانقسامات، ويُظهر كيف أن الدول الأوروبية، رغم التزامها بزيادة الإنفاق العسكري، لا تزال عاجزة عن تنسيق مشتريات دفاعية مشتركة، أو حتى إنتاج الأسلحة الضرورية لدعم أوكرانيا. هذا العجز لا ينبع فقط من نقص الموارد، بل من غياب الإرادة السياسية الموحدة، ومن تضارب المصالح الوطنية بين الدول الأعضاء.
تناقضات بنيوية في المشروع الأوروبي
منذ نهاية الحرب الباردة، اعتمدت أوروبا على المظلة الأمنية التي يوفرها حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، متجنبة بناء قوة دفاعية ذاتية مكتملة. لكن مع تصاعد التهديدات، خصوصًا بعد الحرب الروسية الأوكرانية، بدأت القارة العجوز تدرك أن الاعتماد على واشنطن لم يعد خيارًا مضمونًا، بل أصبح مصدر قلق استراتيجي. في هذا السياق، ظهرت مبادرات أوروبية تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية، مثل «البوصلة الاستراتيجية» التي أُقرت عام 2022، والتي تسعى إلى خلق استقلالية استراتيجية في مجال الأمن والدفاع، عبر الاستثمار في الصناعات العسكرية، وتطوير تقنيات حديثة، وتسهيل الانتشار السريع للقوات الأوروبية. لكن هذه المبادرات، رغم طموحها، لا تزال تواجه تحديات كبيرة، أبرزها الانقسامات السياسية بين الدول الأعضاء، والتردد في زيادة الإنفاق العسكري، وغياب الإرادة الموحدة لتشكيل جيش أوروبي مستقل.
الضعف العسكري الأوروبي لا يرتبط فقط بنقص المعدات أو التمويل، بل يعكس أزمة هوية أعمق: هل تريد أوروبا أن تكون قوة مستقلة قادرة على حماية مصالحها؟ أم أنها تفضل البقاء في ظل الحماية الأميركية، حتى لو كان ذلك على حساب سيادتها؟ هذا السؤال يكشف عن التناقضات البنيوية في المشروع الأوروبي.
الاقتصاد الأوروبي بين التبعية والابتزاز
في قلب العاصفة الجيوسياسية، يقف الاقتصاد الأوروبي أمام تحديات متشابكة، تتراوح بين التبعية للولايات المتحدة، والابتزاز التجاري، والضعف البنيوي في مواجهة القوى الصاعدة. فبينما تفرض واشنطن رسومًا جمركية أحادية الجانب، وتغدق على شركاتها حزمًا تحفيزية ضخمة، تكتفي أوروبا بالاعتراض دون تقديم بدائل تنافسية، ما يجعلها في موقع المتلقي لا المبادر. تعاني القارة العجوز من هشاشة في سلاسل التوريد، واعتماد مفرط على مصادر خارجية، خصوصًا في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا. هذا الاعتماد جعلها عرضة للصدمات، كما حدث في الحرب الروسية الأوكرانية، التي كشفت ضعف البنية الاقتصادية الأوروبية، وأدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وهجرة الاستثمارات، وتراجع النمو إلى مستويات مقلقة.
حتى في الداخل، يواجه الاقتصاد الأوروبي مشكلات هيكلية، مثل ارتفاع معدل الشيخوخة، وتراجع عدد العمالة الماهرة، ما ينعكس سلبًا على الإنتاجية والتنافسية. كما أن القواعد التنظيمية الصارمة، والروتين الإداري، أعاقا الإصلاحات الضرورية، مثل تحديث النظام الضريبي، أو تحفيز الابتكار الصناعي.
الهوية الجيوسياسية لأوروبا.. بين الحلم والواقع
لطالما حلمت أوروبا بأن تكون قوة عالمية ذات تأثير سياسي واقتصادي مستقل، قادرة على فرض رؤيتها في القضايا الدولية، والدفاع عن مصالحها دون الحاجة إلى وصاية خارجية. لكن الواقع يكشف عن فجوة عميقة بين هذا الطموح وبين الإمكانيات الفعلية، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجهها القارة على صعيد الهوية الجيوسياسية. التقرير الصادر عن «فايننشال تايمز» يُسلّط الضوء على هذا التناقض، ويطرح سؤالًا جوهريًا: هل تستطيع أوروبا أن ترى نفسها كقوة جيوسياسية؟ أم أن الانقسام الداخلي والتبعية الاقتصادية والعسكرية سيُرسّخ موقعها كطرف تابع في النظام العالمي؟ الإجابة، كما يبدو، ليست واعدة جدًا. فالدول الأوروبية، رغم التزامها بزيادة الإنفاق الدفاعي، لا تزال عاجزة عن إنتاج الأسلحة الضرورية لأوكرانيا، ولا تملك رؤية موحدة في ملفات الطاقة والاتصالات والتمويل.
الهوية الجيوسياسية ليست مجرد رغبة، بل هي نتاج لتراكمات تاريخية، وقدرة على اتخاذ قرارات جماعية، وتوفر أدوات القوة الصلبة والناعمة. أوروبا، رغم امتلاكها لمقومات اقتصادية وثقافية هائلة، تفتقر إلى الإرادة السياسية الموحدة، وتُعاني من انقسامات أيديولوجية، وتضارب في المصالح الوطنية، ما يجعل من بناء هوية جيوسياسية مستقلة أمرًا بالغ الصعوبة.
«رقصة ترامب الجمركية»
منذ عودته إلى البيت الأبيض، أعاد دونالد ترامب تفعيل أحد أكثر أدواته إثارة للجدل: الرسوم الجمركية. لم تكن هذه الإجراءات مجرد رد فعل اقتصادي، بل تحوّلت إلى سلاح سياسي وتجاري يستخدمه ترامب لإعادة تشكيل العلاقات الدولية وفق رؤيته الخاصة، التي تضع «أميركا أولاً» في قلب كل صفقة وكل قرار. في أبريل / نيسان 2025، أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة شملت أكثر من 180 دولة ومنطقة حول العالم، بنسب تراوحت بين 10% و50%، مستهدفًا الصين بنسبة 34%، والاتحاد الأوروبي بنسبة 20%، والهند بنسبة 26%، وحتى دول صغيرة مثل ليسوتو بنسبة 50%. هذه الخطوة لم تكن مفاجئة، بل جاءت ضمن سلسلة من الإجراءات التصعيدية تهدف إلى تقليص العجز التجاري الأميركي، الذي بلغ 1.2 تريليون دولار في العام السابق. لكن ما يميز هذه السياسة هو استخدامها كأداة ضغط سياسي، لا مجرد وسيلة اقتصادية. فترامب لا يكتفي بفرض الرسوم، بل يلوّح بها كتهديد دائم، يتراجع عنها حين يشاء، ويعيد فرضها حين يرى أن مصالحه السياسية تتطلب ذلك. هذا الأسلوب، الذي وصفته بعض الصحف بـ«رقصة ترامب الجمركية»، يُبقي الأسواق في حالة توتر دائم، ويُربك الشركات العالمية التي لا تعرف متى أو ضد من ستُفرض الرسوم القادمة.
الرد الأوروبي.. بين التهديدات والتردد
في مواجهة التصعيد الجمركي الأميركي، وجدت أوروبا نفسها أمام خيارين: الرد بالمثل أو التراجع تحت وطأة الانقسام الداخلي. وبينما أعلنت بعض الدول الأوروبية استعدادها لاتخاذ إجراءات مضادة، مثل فرض رسوم على المنتجات الأميركية أو اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية، ظل الاتحاد الأوروبي ككل مترددًا، عاجزًا عن اتخاذ موقف موحد وحاسم. هذا التردد لا ينبع فقط من الخلافات السياسية، بل من تفاوت المصالح الاقتصادية بين الدول الأعضاء. فبينما ترى فرنسا وألمانيا أن الرد ضروري لحماية الصناعات المحلية، تخشى دول أخرى مثل هولندا والدنمارك من تداعيات أي تصعيد على صادراتها الحيوية. هذا الانقسام يُضعف قدرة أوروبا على التفاوض، ويجعلها عرضة للضغوط الأميركية، التي تستغل هذا التباين لفرض شروطها التجارية دون مقاومة تُذكر.
في الختام يتجلّى أمامنا مشهدٌ أوروبيٌّ معقّد، تتداخل فيه السياسة بالتجارة، وتتشابك فيه الهوية بالواقع، وتُختبر فيه قدرة القارة العجوز على الصمود في وجه الابتزاز الأميركي والانقسام الداخلي. لقد كشف تقرير «فايننشال تايمز» عن هشاشة البنية الأوروبية في مواجهة التحديات العالمية، وأعاد طرح أسئلة جوهرية حول مستقبل الاتحاد الأوروبي، ومكانته في النظام الدولي المتغيّر.