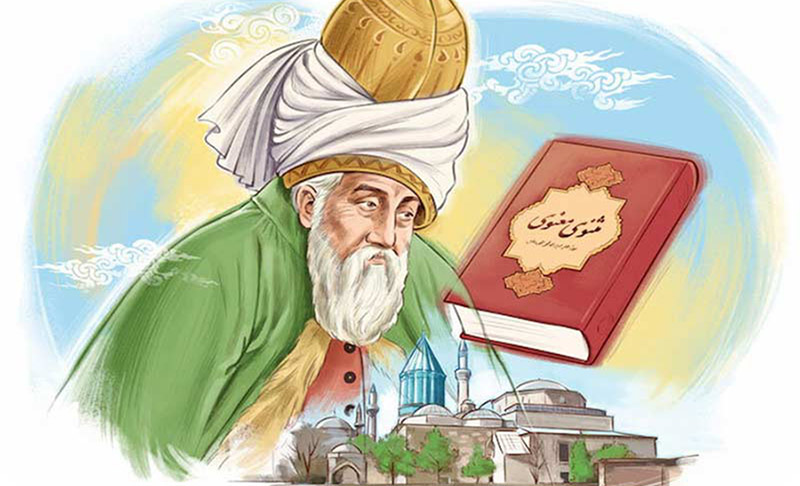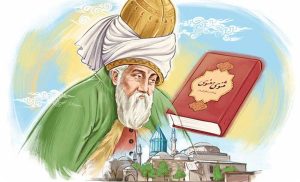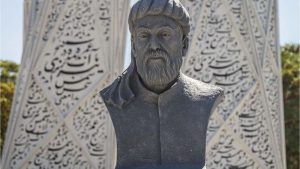يصادف اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر/ أیلول، اليوم العالمي للاحتفال بالذكری السنوية لتكريم الشاعر والأديب والفقيه الايراني الكبير مولانا جلال الدين الرومي واحد من أبرز وأعظم الشعراء في التاريخ، الذي كان له تأثيراً مباشراً على العديد من الثقافات الشرقية والغربية، كما أن مؤلفاته تعد من أهم الكتب التراثية ولا تزال رائجة حتى اليوم وتحقق نسب مرتفعة من المبيعات رغم مضي مدة على كتابتها.
يوم تكريم جلال الدين الرومي
لقد حددت منظمة الأمم المتحدة يوم 30 سبتمبر/ ایلول يوماً عالمياً للاحتفال بالذكری السنوية لتكريم مولانا جلال الدين الرومي وأبياته المستلهمة من المصحف الشريف والأحاديث النبوية، ودورها في تحقيق التعايش السلمي بين الأمم.
يتبوأ جلال الدين المولوي، منزلة رفيعة في الأدب الإنساني عامة والأدبين الإسلامي والفارسي خاصة، حيث بدأت شاعريته في الثلاثينات من عمره، وأخذ ينشد الشعر بلغته الفارسية ارتجالاً دون أن يدرس قواعده وأصوله حتی فاق إنتاجه الأدبي بقية اقرانه من أقطاب الشعر الفارسي.
في يوم تكريم مولانا جلال الدين الرومي، تتجه أنظار العالم إلى شاعرٍ وفيلسوفٍ ومتصوفٍ تجاوزت كلماته حدود الزمان والمكان، لتلامس أرواح الباحثين عن المعنى، وتوقظ فيهم الشوق إلى الحقيقة. وُلد مولانا في القرن الثالث عشر الميلادي، في زمن مضطرب سياسياً ودينياً، لكنه استطاع أن يحوّل التجربة الإنسانية إلى شعر خالد، يتجلى بأبهى صوره في عمله الأشهر «المثنوي المعنوي».
المثنوي.. ملحمة الروح والرمز
المثنوي المعنوي ليس مجرد ديوان شعري، بل هو موسوعة روحية وفكرية، تتألف من ستة دفاتر، وتضم آلاف الأبيات التي تمزج بين الحكمة، والرمز، والقصص، والتأملات العرفانية. كتبها مولانا بالفارسية، لكنها تُرجمت إلى عشرات اللغات، وظلت مصدر إلهام للمتصوفة، والفلاسفة، والباحثين في الأدب المقارن.
يقول مولانا في مطلع المثنوي: «بشنو از ني جون حکایت ميكند.. از جدايي ها شكايت ميكند»، أي: «استمع إلى الناي وهو يحكي، يشكو من الفراق والبعد»، وهي استعارة مركزية في المثنوي، حيث يصبح الناي رمزاً للروح المنفصلة عن الأصل الإلهي، وتبدأ رحلة العودة عبر الحب والمعرفة.
السرد القصصي لدى جلال الدين الرومي
ما يميز المثنوي عن غيره من الأعمال الصوفية هو أسلوب القصص الذي اعتمده مولانا. لم تكن القصص مجرد سرد، بل كانت وسيلة تربوية، وفكرية، وروحية. استلهم مولانا العديد من الأمثال والحكايات من شعراء سابقين مثل سنائي وعطار، لكنه أعاد صياغتها بأسلوبه الخاص، مضيفاً إليها طبقات من المعنى والتأويل.
في قصة «الفيل في البيت المظلم»، على سبيل المثال، لا يكتفي مولانا بنتيجة واحدة، بل يستخلص منها أكثر من عشرة معانٍ، كل منها يضيء جانباً من الحقيقة. هذا التعدد في النتائج يعكس منهجه في تعليم القارئ أن الحقيقة ليست واحدة، بل متعددة، وأن الإدراك يختلف باختلاف الزاوية التي ننظر منها.
ويبدو أن يبدأ حديثه في المثنوي بوعيٍ كامل، وبنيةٍ مسبقة لعرض مفاهيم محددة ضمن مخططٍ موجز ومدروس، لكنه قبل أن يُفصح عن المعنى المقصود بشكلٍ مباشر، تأخذه كثافة المعاني الناتجة عن التداعيات بعيداً عن المسار الأصلي، فتجرفه معها.
فهو، الذي كان في البداية مسيطراً على الكلام والمخطط والمعنى، سرعان ما يصبح خاضعاً ومُسخّراً لتلك المعاني المتدفقة، وحتى يعود إلى ذاته ويستأنف ما بدأه من طرحٍ ومضمون، يكون قد عبر جزءاً من الأحوال والعوالم الروحية.
تصوير الشخصيات.. بين المباشر والمركّب
نظراً إلى أن المثنوي يُعدّ عملاً تعليمياً ـ عرفانياً، فقد سعى جلال الدين إلى التعبير من خلال القصص والتمثيلات عن الموعظة والنصيحة، والتنبيه إلى المسائل الأخلاقية، وكذلك شرح أفكاره ورؤاه العرفانية. ولهذا، فإن القصص في المثنوي تتسم بالشمول والتنوع الكبير، وتُبنى أساساً على الشخصيات الفاعلة والمفعول بها.
وقد استخدم مولوي ثلاث طرق لمعالجة الشخصيات:
– الطريقة المباشرة: حيث يُبدي رأيه في الشخصيات بصراحة.
– الطريقة غير المباشرة: يكتفي فيها بعرض أفعال الشخصيات، ويستنتج القارئ حقيقتها من خلال دورها.
– الطريقة المركّبة: وهي مزيج من الأسلوبين، وتُعدّ الأكثر نضجاً في بناء الشخصية.
وأفضل مثال على تداخل الحكايات يظهر في الدفتر الثالث، ضمن «قصة أهل سبأ وتمردهم على النعمة»، حيث تبدأ الحكاية ثم تُترك دون إتمام، لتُستأنف لاحقاً، مما يعكس أسلوباً متقطعاً يثري البناء الدرامي ويزيد من تنوع الشخصيات.
القصص كوسيلة للترقي الروحي
لم يكن هدف جلال الدين من القصص التسلية أو الإبهار، بل كان يسعى إلى إيقاظ القلوب، وتحفيز العقول. كان يدمج بين الفكاهة والجد، بين الرمز والواقع، ليقود القارئ في رحلة من الإدراك الحسي إلى الإدراك الروحي. في قصص مثل «اللص الساحر» أو «دقوقي»، نرى كيف يستخدم مولانا شخصيات بسيطة ليعبّر عن مفاهيم عميقة مثل الفناء، والتوكل، والعشق الإلهي.
أثر المثنوي امتد إلى قرون بعد جلال الدين الرومي، فكان مصدراً للإلهام لشعراء مثل «جامي»، الذي قلّد أسلوبه في المثنويات، ولأدباء العصر الحديث الذين وجدوا فيه نموذجاً فريداً للجمع بين الشعر والفلسفة. حتى اليوم، يُقرأ المثنوي في حلقات الذكر، وفي الجامعات، وفي المحافل الأدبية، باعتباره نصاً حياً لا يفقد بريقه.
وقد أقر جلال الدين الرومي بتأثره بأسلافه، فقال: «عطار روح بود وسنايي دو جشم او، ما از بي سنايي وعطار آمدیم» أي: «عطار هو الروح، وسنائي هما عيناه، ونحن جئنا بعد سنائي وعطار»، مما يدل على امتداد فكري متصل، لكنه بلغ ذروته في المثنوي.
في ذكرى جلال الدين.. دعوة للتأمل
تكريم جلال الدين الرومي ليس مجرد احتفاء بشاعر، بل هو دعوة لإعادة التواصل مع جوهر الإنسان، مع الرحلة الداخلية التي يخوضها كل فرد في بحثه عن الحقيقة. المثنوي يعلّمنا أن القصص ليست فقط للتسلية، بل هي مرايا للذات، وأدوات للكشف، وجسور نحو المعنى. في زمن تتسارع فيه الحياة، وتضيع فيه الروح بين ضجيج المادة، يظل صوت الناي الذي بدأ به المثنوي، نداءً خالداً لكل من يبحث عن ذاته، وعن الله، وعن الحب الذي لا يفنى.