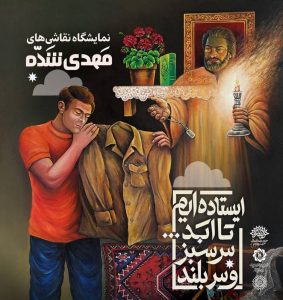في معرضها الجديد “نزهة في الطبيعة”، تحاول الفنانة فاطمة الحاج إخراج الزوار من الواقع الصعب، ونقلهم إلى عالمٍ موازٍ من الألوان والبهجة، استقته من أبحاثها وأسفارها.
تنقل الفنانة اللبنانية المخضرمة فاطمة الحاج زائر معرضها، المعنون “نزهة في الطبيعة”، من عالم واقعي مشوب بالتوتر والقلق، إلى عالم من الخيال والبهجة، بَنَته يداها خصيصاً من أجل تعزيز صراع اللبناني مع واقعه المرير، بل هو الصراع الي يخوضه إنسان العالم المعاصر بصورة عامة.

يضمّ المعرض المُقام في “غاليري مارك هاشم” في بيروت، مجموعةً من اللوحات الكبيرة، أو الجداريات الانطباعية، المزدانة بالألوان الزاهية، التي خلقت منها فاطمة الحاج فردوساً افتراضياً. هو عالم مرئيّ بوضوح، بتفصيلاته وألقه، عاشته الحاج إلى مدى واسع، قبل غرق العالم في متاهة النظام الليبرالي الذي طغى عليه، ونشر فيه دماراً شاملاً وحروباً لا تنتهي، وكان لبلدها لبنان حصة كبيرة من تخريبه.
عايشت الحاج مرحلة درجت تسميتها بـ”الزمن الجميل”، ويتّضج جماله بشكل أوضح بالمقارنة مع المأساة التي نعيشها اليوم، ونتعايش مع ارتداداتها، فقد كانت تلك المرحلة مشوبة بالكثير من سلبيات الحاضر، إلّا أنّها كانت مفعمة بعناصر كافية تؤهل لرومنطيقية جميلة، لم تعد بمتناول إنسان اليوم.
الفنان المرهف الإحساس يستشرف الزمن. يتلمّس ما ينتظره. يبدأ البحث في قدراته وإمكاناته عن بديل لواقع لا يد له فيه ولا تأثير. يستجمع قواه وثقافته وقدراته، ويستنفر مخيّلته وأحاسيسه ليبني عالماً آخر يلجأ إليه لكي يستطيع الاستمرار.
لم يكن عمل فاطمة الحاج سوى تلك المحاولة، ركيزتها الطبيعة التي “تجد فيها توازنها خاصة في الأزمات الكبيرة”، كما قالت لـ”الميادين الثقافية”، مضيفةً أنّ “الدواء الذي أعالج به نفسي عندما أمرّ بأزمات كبيرة، مثل كل إنسان، هو الطبيعة؛ ألجأ إليها وأحاورها وأتحدّث معها، فتهدّء لي بالي بعنوانها الهادئ، وتناسقها الجميل مع الظلال والشمس، والتنوّع الطبيعي الجميل والواسع، ولا نقدر أن نحصي كل ما فيه من جمال”.
الأزمات التي عاشها الناس تفاقمت في فترة “كورونا”، حتى جاء تفجير مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس فأوصل المأساة إلى ذروتها، بنظر الفنانة الحاج، التي عايشت هذه الأزمات حصاراً ومنفى، كما تقول، موضحةً أن “هذا المعرض جاء ليقول للناس إنّه ما زالت هناك بارقة أمل، وفسحة أمان للتأمل”، مردفةً أنه “علينا أن نتابع الحياة، ونريد أن نعيش، وعلينا مسؤوليات للقيام بها في هذا الزمن الصعب جداً”.
المعرض
يبدو أثر المدرسة الانطباعية جلياً في معرض الحاج، فهي تأثرت بعصر الرومنطيقية في دراستها الأكاديمية، ولطالما أعربت عن تأثرها بأستاذ الانطباعية اللبنانية شفيق عبود، والانطباعيين الفرنسيين مثل ماتيس و فويّار وبونار.
اللوحات مفعمة بالألق والألوان الزاهية، التي أعادتنا الحاج من خلالها إلى زمن الرومنطيقية الذي قضت عليه الحداثة، وراحت تبحث فيه عن بدائل. لجأت إلى الشعر، فعثرت على عناصر الحروب الأهلية الراهنة في تواريخ سحيقة. لمست الحرب الأهلية يوم اشتدّ النزاع بين أليسار وشقيقها في مدينة صور القديمة، قبل آلاف السنين، لكنّ أليسار هربت وبنت قرطاج ولم تنخرط في الحرب، خلافاً للرائج بين اللبنانيين.
تقول الحاج: “هذا المعرض هو أنا بطريقة عملي الفني، أشتغل مواضيع مختلفة عن الطبيعة بألواني الخاصة، بالألوان التي علّمتني الطبيعة إياها، وتعلّمتها من كبار الأساتذة والفنانين، إن مباشرة أو بالاطلاع على أعمالهم وأفكارهم ومنجزاتهم”.
عثرت في أبحاثها على قصص تنقل القارئ إلى عوالم الخيال والتألق والحلم، فوجدت في “أوروب” و”قدموس” أملاً، عندما علّم الفينيقي الأبجدية للعالم، وعثرت على ابن سينا، الطبيب والعالم والموسيقي، من خلال فيلم وضعه السوفيات عنه سنة 1956، فضمّنت كتابات الفيلم في لوحاتها، لتحوّل اللوحات إلى حالة توثيقية إلى جانب كونها فنيّة.
تستلهم الحاج ابن سينا كطبيب، وكيف أوضح ضرورة تعقيم النقود والأيدي بالخلّ، ووضْع ورقٍ معقَّمٍ على الأنف (كمامة) من أجل التنفس السليم. وتنقل عنه كذلك أنّه “في زمن الأوبئة، خاطب الناس داعياً إياهم إلى تسكير الأسواق، والمكوث في المنازل، وإقفال المؤسسات والمساجد والصلاة في المنزل، وعدم تبادل الزيارات والمصافحة بالأيدي. وإذا حدث ذلك، فليعقم كلٌّ يديه بالخلّ”.
تصف الحاج ذلك بقولها: “كأنّه يصف كيفية تجنّب الكورونا”، مُعدّدة الكثير من مزاياه التي ضمّنت بعضاً منها في لوحاتها.
توغل الحاج في أبحاثها بعيداً عن اضطراب المرحلة والزمن، فتعثر على العالِم العربي ابن الهيثم ، وتتابع مستشرفة رومنطيقية الشاعر الفارسي “نظامي”، وتستلهم من روحيته أبعاداً إنسانية. تقول: “متى وصلت إلى الهدوء والسكينة رحت نحو التصوّف، لأنّنا نحتاج إلى حالات من السموّ والهدوء والتأمل والتعمّق”.
في انخراطها بالطبيعة حدّ الذوبان، يتوقف الفصل بين الذات والطبيعة ويتماهيان، ويصبح الإنسان جزءاً من الطبيعة، وهي جزء منه، وكلّ ذلك هرباً من الأزمة الكبرى، وبحثاً عن الأمل. وعن هذا الجانب من حركتها الفنية – الثقافية، تخلص الحاج إلى أنّ “ذلك كلّه يلعب دوراً كبيراً في المنظر الطبيعي ذاته، والمنظر الطبيعي يؤثر بكلّ هذه الأبحاث، كما تؤثر الأبحاث في المنظر الطبيعي”.
الفنانة
ولدت فاطمة الحاج في العام 1953، ودرست في “معهد الفنون الجميلة” في الجامعة اللبنانية، ثم في “معهد لينينغراد” للفنون الجميلة في روسيا، ولاحقاً في “المدرسة الوطنية العليا للفنون التشكيلية” في باريس.
عملت مدرِّسةً في “معهد بيروت للفنون الجميلة” منذ العام 1985، وهي السنة التي نالت فيها “جائزة بيكاسو” في مدريد، وحتى سنة 2017. ومنذ سنة 1986.
في تجوالها على دول العالم، استلهمت مناظر الطبيعة والحياة العامة الجميلة في مختلف البلدان، فكانت عناصر تألّفت منها لوحاتها التي آثرتها كبيرة الحجم.
أقامت العديد من المعارض المنتظمة، في كلٍّ من لبنان وفرنسا وإسبانيا، وعدة بلدان عربية. تمّ تكريمها في الكويت والإمارات والبحرين وسوريا والمغرب وقطر.