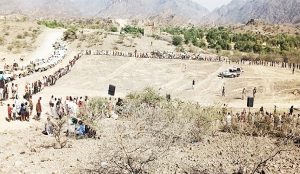إنّ الأعمال التي تقع في مرتبة الوجوب في الشريعة الإسلامية هي تلك التي يأثم المرء بتركها ولو شغل الوقت الذي وجبت فيه بأشياء أخرى تبدو نافعة، لأنها في تلك اللحظة يجب أن تُقدَّم على غيرها، ولا ينشغل بشيء دونها. وعلى ذات الوتيرة فإننا عندما نتحدث عن عمل يُمثِّل واجب الوقت في السير نحو نهضة الأمة وبلوغ رشدها فإننا نعني به أنه يجب أن يتقدم على غيره أو يوازيه -حسب سياق العمل المقارَن- وإلا فإننا سنقع في عنت غفلتنا عن هذا الثغر.
جهود وإخفاقات نهضوية
منذ القرن التاسع عشر خرجت عشرات الأطروحات النهضوية، وتباينت بسبب اختلاف المرجعيات التي انبثقت منها، والرؤى التي تبنتها على ضوء تلك المرجعيات، مما أفضى إلى تنوعٍ في هذه الأطروحات ما بين الرصين والمتهافت، والأصيل والمقلد، وما بين من أدرك مقومات الرشد للأمة ومركزياتها فسار في رحابها، ومن ذاب تحت سطوة الثقافة الغالبة، ومن بين من اهتم بالكليات والمسارات الفكرية الكبرى والسنن الكونية في التغيير، ومن دقق في جزيئات المجتمع وحلله، واقترح حلول له، ورأى أن نقاء الصورة الكلية لا يتأتى إلا من سلامة أجزائها المكوِنة لها.
وبالرغم من هذا الكم الضخم من الأطروحات والذي ينم عن انشغال عقل الأمة لاستعادة ريادتها ضمن مقوماتها وهُويتها الخاصة، وأنّ سؤال: كيف ننهض؟ بمختلف الأفهام التي على ضوئها تم تحرير مصطلح النهوض، يُعد سؤالًا ضاغطًا منذ قرون.
إلا أننا إذا نظرنا إلى مجموع حال الأمة، فلن نحتاج مجهودًا كبيرًا كي ندرك أنّ الكثير من هذه النِتاجات النهضوية لم تكن سوى في عقل المفكر، ولكن المساحة التي استطاعت فيها هذه الأطروحات أن تتجسد وتُعمل أثرها في الناس مساحة لا زالت ضيقة لا يتمثلها الوعي الجمعي، حيث إنّ الحاضنة المجتمعية بمجموعها سلوكيًا متأثرة بعدد كبير من الروافد الداخلية والخارجية سواء على المستوى الديني أو النفسي أو الاجتماعي جعلتها مجوَّفة لدرجة تهدر أي جهد إصلاحي، ويجعل الخطوات التي تدفعها للأمام متعثرة متلجلجة.
إنّ الأسباب التي حالت دون تجسُّد جُل هذه الأطروحات على أرض الواقع كثيرة جدًا ومتشعبة، وتتطلب تحرير دقيق لكل أطروحة ومقدِّمها، وطبيعة العصر الذي كان يعيش فيه، والظروف الخارجية المؤثرة، والتغيرات النفسية والاجتماعية والثقافية التي تحدث على إثر تلك الظروف، والأخطاء المنهجية التي وقعت فيها بعد تحديد المعيار الصحيح المبني على مرجعية الأمة -أي الوحي والسنة-.
وبالرغم من أنّ هناك عشرات الكتب والمحاضرات -إن لم يكن مئات- خُصصت في بحث هذه الأسباب أو الدندنة حولها، إلا أننا نرى جملة من الإشكالات التي ضعفت وقللت من قيمة وفاعلية هذا النقد ومن أهمها هو ما يمكن أن نسميه الإزاحة الزمنية التي تقع فيها الأطروحة، حيث تخرج -بين الفينة والأخرى- أطروحات -أيًا كان توجهها- تتدحرج بين الأخذ والرد والسجالات حول منطلقاتها وأفكارها ومدى جدواها، وريثما يستقر صاحبها على الصيغة النهائية لها التي يخرجها في هيئة كتاب أو غيره، يكون قد وقع عدد من التغيرات والتحركات في الكتل والتراكيب الاجتماعية الصغيرة على أصعدة متعددة، وبالتالي فإن الصورة الكلية التي بنى عليها أطروحته تغيرت -ولو تغيرًا طفيفًا-، مما يعرقل فاعليتها، وهذه هي الضربة الأولى.
أما الضربة الثانية تتجلى في لحظة خروج الأطروحة، حيث تتناولها أيدي النخبة من المفكرين والباحثين وغيرهم، فتُحصَر في هذا السياق الأكاديمي التنظيري الذي يتسم بضعفٍ في اتصاله مع الحاضنة المجتمعية، ويندر فيهم من ينقلها إليهم.
أما الثالثة تقع عندما تصبح هذه التغيرات المجتمعية التي أفضت إلى بروز قصور الأطروحة جلية لعموم النخبة بسبب الإزاحة الزمنية الكبيرة جزئيًا، فيتناولونها بالنقد والرد والتعديل في دحرجة جديدة لها، فتصبح في النهاية بمثابة (سِفر لامع) يطّلع عليه المختصون لفهم ودراسة هذه الحقبة الزمنية أو طيف منها، أو تندثر نهائيًا، وبالرغم من أن هناك القليل من الأطروحات التي نُصِبت على أساس السنن الكونية ومرجعية الوحي، والتي لا تزال تحمل الحيوية والريادية التي اكتسبتها من منطلقاتها، إلا أنها لا زالت حبيسة الدائرة النخبوية. مما يجعلنا نُعيد النظر حول نوعية الأطروحات النهضوية، وآلية تفعيلها.
تربية الإنسان المسلم جوهر النهضة
من خلال النظرة الكلية التي طرحناها سابقًا يتضح لنا بجلاء أن نوعية الأطروحات النهضوية يجب أن تتمحور أولًا حول ترميم وإصلاح الحاضنة المجتمعية بكافة العوامل المؤثرة عليها، إذ إنّ عدم جاهزيتها لنفوذ تلك الأطروحات خلالها وانعدام القابلية سبب رئيس من أسباب تعويقها، إذ إنّ مناطها، وأول ما يجب أن يُبدأ به في هذا الإصلاح هو إصلاح جوهر هذه الحاضنة ومكونها الأساس الذي هو الإنسان، حيث إنّ إصلاح الحد الأدنى من عموم الناس الذي يُنتج وعي كلي هو الذي يُفضي إلى إصلاح الحاضنة المجتمعية ككل والوصول إلى النقطة الحرجة من الوعي التي تسمح بانتقال المجتمع من حالة إلى أخرى.
ما هي المشاكل التربوية التي حالت دون صناعة هذا الإنسان؟
عندما ننظر إلى المكتبة العربية سنجد عشرات بل مئات المصادر والكتب والمحاضرات التي تحدثت عن التربية من جوانب عدة، فهو باب واسع صُنِف فيه كثيرًا قديمًا وحديثًا، وبالرغم من ذلك نجد إشكالات ضخمة في هذا الثغر المركزي منها:
١– تحرير مصطلح التربية: والحق أن تحرير مصطلح التربية أمرٌ بالغ الأهمية، لأن غالب الناس يعتبر نفسه محققًا له قائمًا به ولا يحتاج إعادة النظر فيه أو معالجة وضبط بعض الجوانب، ولكن عندما ننظر إلى الواقع نجد بونًا شاسعًا وتفاوتًا كبيرًا بين الناس في أساليبهم وتطبيقهم لهذا المصطلح، وعندما نبحث عن السبب نجده راجعًا -غالبًا- إلى الاختلاف في تحرير وفهم التربية، فهذا يراها مرادفًا للرعاية، وذاك يفسرها على أنها التربية الإيجابية من منظور غربي، وهؤلاء يرون تحقيقها بالدلال أو بالقسوة والعقاب والتعنيف …إلخ، وكلهم يرى أنه محققٌ لها ويتعجب من الدعوات التي تتحدث عن البناء التربوي الصحيح.
والحق أنّ تحرير هذا المصطلح يجب أن يكون على المعيار الإسلامي الذي كان عليه الرعيل الأول، فإذا بحثنا عن المعنى اللغوي لجذر التربية سنجد أنه مشتقٌ من الجذر رَبا، ونقول “رَبا الشيءُ يَرْبُو رُبُوّاً ورِباءً: زَادَ وَنَمَا. وأَرْبَيْتُه: نَمَّيته”[لسان العرب]، فمعاني النماء والزيادة في الإنسان المسلم تعتمد أساسًا على تحقيق العبودية لله عز وجل والتزكية وتعلُّم هذا الدين وحمل همّه، وهذه هي المركزيات التربوية التي تمحورت حولها تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فقد قال الله عز وجل {لَقَدۡ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِینَ إِذۡ بَعَثَ فِیهِمۡ رَسُولࣰا مِّنۡ أَنفُسِهِمۡ یَتۡلُوا۟ عَلَیۡهِمۡ ءَایَـٰتِهِۦ وَیُزَكِّیهِمۡ وَیُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَـٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبۡلُ لَفِی ضَلَـٰلࣲ مُّبِینٍ} [آل عمران :١٦٤]، ووسيلة تحقيق ذلك تتضمن نقاط كثيرة أولها وأهمها هو جاهزية المحل الذي سيباشر هذه المهمة _ أي المُربي_ وهذا ينقلنا إلى النقطة الثانية.
٢- تزكية المربي لنفسه: من المستحيل أن يربي تربية صحيحة من لا يُربي نفسه أولًا، إذ إنّه دون تزكية وصلاح ذاتي وإصلاح -على الأقل في محيط أسرته- لن يتمكن من نقل هذه المعاني لغيره، ففاقد الشيء لا يعطيه، وسيظل متخبطًا في تعامله معهم، ولن ينجح الوالدان في إخراج إنسان مسلم سوي، بل ستخرج أجيال تحمل ذات الإشكالات التي أفضت إلى الشكل الحالي للمجتمع معجونة بمزيد من التحديات التي تتولد من تقلبات العصور ومستجداتها. وسبيل تحقيق هذه التزكية يكون بعرض النفس على القرآن ووزنها عليه، والاطلاع على كتب التزكية لعلماء المسلمين، وتربية النفس ومرانها على تلك المعاني.
٣- الرؤية والمهارة: إن ضبط مصطلح التربية وتزكية النفس ليسا كافيين للسير في عملية تربوية سليمة، لأن انعدام الرؤية والخطة في التربية ووضع أسس وقواعد للسير عليها ستجعل أمواج الحياة من هذه الأماني الأولى في تربية الأبناء طيفًا عابرًا وذكرى جميلة.
وكذا المهارات التي سيتم بها نقل هذه الرؤية وتحقيقها والاستمرار عليها، وإلا ستظل حبيسة الأنفس والأوراق.
ما هي أنواع التربية التي يجب علينا العمل عليها؟
إذا نظرنا إلى المجتمع النموذج وهو المجتمع النبوي الذي عمّره سيد الخلق وأصحابه، نستطيع أن نستشف منه التركيبة المجتمعية التي تعطينا تصوُّر عن طبيعة المجتمع المسلم الصحي الذي يجب أن نكون عليه، فالمجتمع النبوي حوى فئات متنوعة من المسلمين أنفسهم -فضلًا عن الأصناف الأخرى-، فالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا آلافًا، ولكن جلهم ليسوا معروفين لنا لأنهم كانوا مسلمين صالحين مُسَلِّمين لله تبارك وتعالى ولرسوله، يقيمون مركزيات الإسلام على أتم وجه دون أن يكون لهم دور إصلاحي خاص مثل بعض أعلام الصحابة كالخلفاء الراشدين وغيرهم ممن تميزوا في ميادين إضافية إصلاحية كالعلم وغيره، فهؤلاء كانوا غالبية المجتمع، وفي كثير منهم جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنّ رسول الله ﷺ قال: (طُوبَى لعبدٍ أخذ بعنانِ فرسِه في سبيلِ اللهِ أشعثَ رأسُه مُغبَّرةٍ قدماه إن كان في الحراسةِ كان في الحراسةِ وإن كان في السَّاقةِ كان في السَّاقةِ إن شفَع لم يُشفَّعْ وإن استأذَن لم يُؤْذَنْ له) [رواه البخاري].
ومن هنا سندرك أنّ التفاوت كان كبيرًا وأنّ غالب المجتمع كان صالحًا وأقله مصلحًا، ولكن الجميع تمحور حول التسليم لله ورسوله تسليمًا تامًا حتى في تنفيذ العقوبة لمن زلَّ ووقع في خطأ، وطبيعي جدًا أن يخطئوا لأنهم ليسوا معصومين، لأن نموذجهم ليس فردوسيًا مثاليًا، وإنما واقعيًا قابلًا للتطبيق.
وعليه سندرك أنّ مستويات التربية مختلفة، فهناك تربية عامة وهي التي يجب أن تعم غالب المجتمع، ويتحقق بها شروط الصلاح والتسليم لله ورسوله، مما ييسر مهمة الفئة الثانية.
صناعة المصلحين.. جوهر التربية الخاصة
وهي تربية تتحقق بمعايير أعلى حتى يخرج منها نماذج معيارية إصلاحية تستطيع أن تأخذ بزمام التغيير والإصلاح، وتجد حاضنة مجتمعية مُهيأة بشكل عام لتقبل هذا الإصلاح والتغيير.
ما سُبل صناعة تلك النماذج؟
الحقُ أنّ هذا طريقٌ طويلٌ للغاية، ولكننا إذا استوعرناه وترددنا في خوضه لاستعجالنا النتائج والتفاتنا عنه بحثًا عن الطرق السهلة والسريعة، فكبِّر أربعًا على بزوغ شمس الأمة من جديد، لأنه كما وضحنا يجب أن تدور الأطروحات الإصلاحية في فلك إصلاح الحاضنة المجتمعية، ومن لطف الله بنا أنه قصَّ علينا في كتابه نموذج مماثل يسلينا أثناء خوض غِمار هذا الطريق الممتد، وهو موسى عليه السلام، إذ إنّ الله تبارك وتعالى لمّا كتب النجاة لبني إسرائيل لم يبعث من رجالهم نبيًا، ولم يخسف بأعدائهم الأرض -وهو على ذلك قادر عز وجل- وإنما جعل السبيل إلى ذلك مولودًا صغيرًا سيُصنع على عينه من مهده، ويربى ويربو تربية إلهية، ثم يكون التمكين على يديه!
فمن الواضح أنّه وسط النماذج النبوية التي قصها الله علينا لنعتبر بها ونُعملها في حياتنا وفي طريقنا الإصلاحي سيكون نموذج موسى عليه السلام هو نموذج وشعار هذه المرحلة من الأمة، وعليه فيجب على أرباب الأسر الحالية والمستقبلية والمحاضن التربوية أن يعدوا أنفسهم جيدًا ليكون هناك قابلية لصناعة تلك النماذج، ثم يشقوا الطريق الذي اصطفاه الله عزّ وجل لكليمه.
ختامًا
لقد عرَّجت في هذا المقال على النقاط المركزية دون تفصيلها، وعبرت عبورًا سريعًا عليها في محاولة للّم شمل الصورة الكاملة في سياقٍ مقتضب، وإلا فإن التفصيل في كل نقطة سيطيل هذا المقام، لذا فدورك أيها القارئ الكريم الذي استشعر مسئوليته تجاه الأمة وفي هذا الدرب أن تبدأ الآن بإعداد نفسك تزكويًا وفكريًا وأخلاقيًا ونفسيًا لهذه المهمة العظيمة، ثم انظر إلى نفسك بعدها، هل سيخرج من تحت يديك صالح؟ أم أنك ستصنع بإذن الله وتوفيقه مصلحًا تخوض لأجل صناعته طريق موسى عليه السلام؟