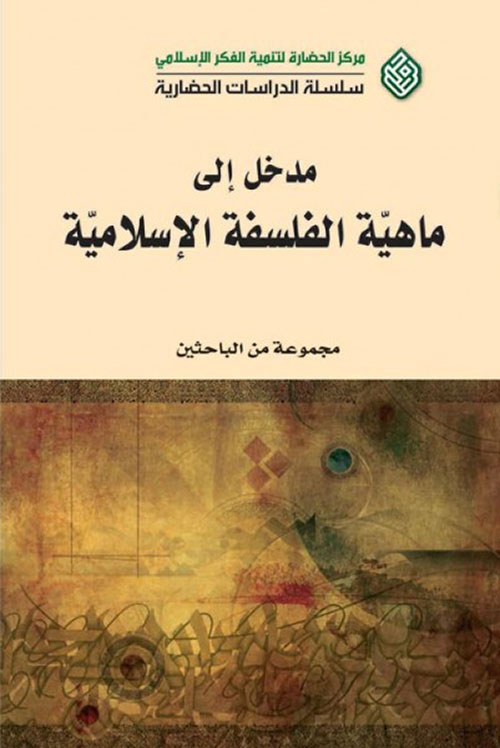يطرح الكتاب مجموعة أسئلة تخصصيّة مُقدماً الأجوبة لها على لسان هؤلاء الباحثين، وهي: ما هي الفلسفة؟ هل الفلسفة الدينية أمر ممكن؟ ما هي الفلسفة الإسلامية سواء في مقام التحقق أم في مقام التعريف؟ وما الخصوصية التي تتميّز بها عن كل من العرفان وعلم الكلام؟ ما هي الغاية التي تتوخاها الفلسفة الإسلامية؟ هل الفلسفة الإسلامية محصورة في إطار المدارس الثلاثة: المشائيّة، أو الإشراقيّة أو الحكمة المُتعاليّة؟ ما هي العلاقة بين تفلسف الفلاسفة المسلمين وبين الدين؟ ما هي الصلة بين الفلسفة الإسلاميّة والفلسفة اليونانيّة؟ هل من فروع للفلسفة الإسلاميّة؟ وما هي هذه الفروع؟ وهل هذه الفلسفة الإسلاميّة حيّة متحركة أم أنها تحوّلت إلى ظاهرة تاريخية؟
تُعد هذه الحوارات الموّجهة والمتخصصة جزءًا من حراك مطلوب ذي منافع جمّة، خاصّة لطلاب الفلسفة الذين يُعانون من النقص في النص العربي الفلسفيّ الغائب والمُتكّل على الترجمات العربيّة غير الكاملة، دوما، للفكر الغربي المعاصر.
والكتاب هذا هو تأسيس لفكر إسلاميّ في العصر الحديث، ويسدُ ثغرات في الجانب الفكري، كما أنّه يُضيئ على فكر الأسلاف، وإن كان غير مكتمل، بل ناقص بسبب الفرق الزمني.
سيطرت الفلسفة اليونانيّة على الفكر الإسلاميّ طويلاً رغم انتقال الفلسفة الغربيّة إلى مراحل فلسفيّة جديدة حداثوية كالأنسنة والوجودية والميتافيزيقا، ولم تُنْتج فلسفة إسلاميّة حديثة حتى اليوم لدرجة أنها حصرت نفسها بالترجمات الرديئة سواء اللبنانيّة أو المصرية أو المغربيّة التي شوّهت الفلسفة الغربيّة غالباً. ولكن هل الوضع هو نفسه فيما يتعلق بالترجمات إلى الفارسيّة؟ وهل استوعب الإيرانيون الفكر والفلسفة الغربيتين أكثر من المفكرين والمترجمين العرب؟ ولما لم يستفد الفكر العربي من الفكر الفلسفي الفارسي بتاتاً؟
فلقد انحصر الفكر الفلسفيّ الإسلاميّ بمسائل الفكر والعدم والوجود والخلق، وظلّ حبيس مجموعة “تيمات” غير معاصرة، إلى أن نهضت أوروبا بعد خلعها الرداء التقليدي القديم، وارتدت ثوب الحداثة على الصعيد الفكري، وكان أن طعّمت الأفكار الإسلامية حاليّا ببعض النتاج الغربي نتيجة تلاقح بعض مفكري طهران مع المدارس الأوروبية.
هذا وكان المسلمون قد اعتمدوا على منهج خاص بالفلسفة، غير تجريبي، وهو المنهج العقلي البرهاني، وابتعدوا عن الفلسفة الوضعيّة. وانطلقوا من القرآن الكريم لتقديم فلسفتهم الإسلاميّة سواء في العصور الأولى أو العصور اللاحقة أو الحديثة، وأخذوا أولويات العمل من داخل العقيدة الدينيّة الإسلاميّة. من هنا كان الإبداع الفكري مُحدداً بنتائجه المعروفة سلفاً، ولم يكن الخلاف، سواء بسبب الفروقات المذهبية المُستمدة من جذور الخلاف الأساس بين السنّة بمذاهبهم الأربعة المُعترف بها، وبين المذاهب الشيعيّة المتنوعة ما بين الباطنية، والإثني عشرية، والعلوية. وإن كان البعض يرفض تسمية الفلسفة بالإسلاميّة أو غير الإسلاميّة، خاصة أنّ الصفة الدينية تمنع الابداع والتميّز لكون نتاج الفكرة معروف سلفا.
ختاماً ما يُؤخذ على الفلسفة العربيّة أن فلاسفتها كانوا في الغالب من غير العرب، وعلى الفلسفة الإسلامية أنّها استمدت أوليات تفكيرها من الفلسفة الأرسطيّة اليونانيّة وما بعد الأرسطيّة، ولم تصنع فلسفتها الخاصة بها. وجلّ تركيز الفلاسفة المسلمين بدأ واستمر في سبيل استعمال الفلسفة كأداة للدفاع عن العقيدة فقط.
أ.ش